شرفة تطل على ميدان التحرير
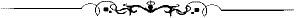
 |
ميدان التحرير |
بقلم : د. هبة رؤوف عزت
................................
أسكن في مكان، ويسكنني..أسكن في هذا الميدان الفسيح الذي تطل عليه شقتنا منذ ولدت، تجولت عيني منذ أيامي الأولى في أنحائه لترى من الشرفة العريضة البنايات الرابضة في جنباته وتلمح النيل عن بعد يجري كما الدم في وريدي .. وفي الأفق صافح بصري منذ الطفولة مشهد الأهرامات عن بعد واضحاً كل صباح..لا يحجبه إلا الضباب أو رمال الخماسين. ميدان التحرير..قلب القاهرة..وقلبي.
أين تسكنين في ميدان التحرير؟!! في منطقة معروف؟ في ناحية باب اللوق؟ في اتجاه طلعت حرب؟ عند مجلس الشعب؟ في جاردن سيتي؟ ربما أكون قد سمعت هذا السؤال في عمري آلاف المرات. أسمع مجدداً صوتي يرد:" في الميدان".
باستغراب يأتي السؤال التالي:"وهل يسكن في ميدان التحرير "نفسه" أحد؟ أو ليست كلها مكاتب وعيادات وشركات؟" بل يوجد سكان أصليين..أسرتنا وعشرات غيرها، عاشت قبل زحف المكاتب والعيادات والشركات.
ملتقى الحضارات
كان والدي الذي ولد في العشرينات يسكن في بيت تملكه أسرة والدته في العباسية، وتنوعت أماكن عمله إلى أن استقر به الحال كضابط شرطة في إدارة الجوازات بمجمع التحرير بنهاية الخمسينات..فقرر أن يسكن في أقرب مكان من عمله، ووجد شقة في واحدة من عمارتي سرباكيس التي تطل على الميدان والتي تقع في صف البنايات الذي يربط بين مدخل شارع طلعت حرب ومخرج شارع البستان.
صوري وأنا صغيرة تظهرني وأنا واقفة وخلفي المتحف المصري يبدو من بعيد وفي يمين الصورة فندق هيلتون النيل..وجزء من حديقة جامعة الدول العربية. لم تلتقط عدسة الكاميرا مبنى وزارة الخارجية الكلاسيكي القديم ومسجد عمر مكرم و المجمع ثم مبنى الجامعة الأمريكية ثم عمارة أسترا التي كان تحتها المقهى الشهير وكافيتريا زد والبناية العتيدة الأقدم ذات الطابقين على ناصية شارع التحرير، ثم مدخل شارع طلعت حرب.
من الحضارة الفرعونية القديمة التي يمثلها المتحف المصري ومشهد الأهرامات، والحضارة العربية التي ترمز لها جامعة الدول العربية، والإسلام الذي يؤذن في رحابه للصلاة خمس مرات من مسجد عمر مكرم ، وهوية النيل الذي يجري حراً ، وانتماء الدولة المصرية التي تمثلها وزارة الخارجية وبيروقراطية مبنى المجمع الضخم ، إلى خريطة العالم الذي يمثله فندق الهيلتون (والذي يقوم الآن مكان معسكرات الجيش الإنجليزي أيام كان الميدان في ظل الاحتلال يسمى ميدان الإسماعيلية ومن هنا جاءت التسمية بعد رحيل الاستعمار)، كما تمثله الجامعة الأمريكية...تشكل وعيي بالدنيا، من هذه الشرفة أطلت عيني على العالم، وتشكل أفقي تفكيري.
كنا صغاراً نعبر كوبري قصر النيل مشياً إلى نادي الشرطة أو النادي الأهلي أو نادي الجزيرة، في النادي الأول كنت وأخي خالد الذي يكبرني بعامين نمارس الرياضة من سباحة وتنس ، وفي الناديين الأهلي والجزيرة نشاهد والدي يدرب فريق الهوكي حيث كان كابتن الفريق في الخمسينات ثم مدربه في الستينات وحتى مطلع السبعينات..وهو ما أتاح له السفر لبلدان كثيرة في إطار البطولات الدولية معظمها من دول "عدم الانحياز" من الهند وباكستان حيث تنتشر اللعبة أكثر من البلدان العربية، إلى دول جنوب الصحراء في أفريقيا، فكانت معرفتي بهذا العالم وأسماء المدن وأحوال الناس مبكرة، بمثلما تعرفت على العالم الغربي من خلال عين أبي في زياراته الأخرى لأوروبا الغربية والشرقية والولايات المتحدة...
مدرستي الألمانية التي كانت تبعد عن بيتنا سبع دقائق مشياً على الأقدام أيضاً كانت مشهداً متنوع الوجوه، الراهبات اللاتي يمثلن الوجه المسيحي للحضارة الغربية، والمدرسين الذين يغلب علي شبابهم الطابع الليبرالي وعلى الأكبر سناً منهم الطابع الصارم لجيل الحرب العالمية الثانية.
كانت تلك أطياف من الثقافة الألمانية لكنها كانت أيضاً أماكن، الراهبات يسكن في دار الراهبات الملحقة بالمدرسة حيث مساحة الرهبنة، والعبادة في الكنيسة الصغيرة .
والمدرسون يسكن عقلهم مساحات الحداثة والنظرة العقلانية والفردية، والأكبر ذاكرتهم أسيرة مساحات الحرب ومعاناة ما بعدها. لكن بالمدرسة تجلت أيضاً مساحة الإسلام كهوية في أبلة كوثر التي أصرت على أن تشترك المدرسة في مسابقة المنطقة التعليمية للقرآن الكريم للمرة الأولى (وربما الأخيرة) في تاريخ المدرسة ، واختارتني لأن أمي كانت المرأة المحجبة الوحيدة التي تحضر مجلس الآباء في مطلع السبعينات، فحفظت الجزئين الأخيرين من القرآن وأنا ابنة سبع سنين وفزت بالمركز الثالث ، كما كانت مدرساتي من أبلة ماتيلدا إلى أبلة إيفون إلى مدام سوزان وغيرهن يفضن بروح مسيحية قبطية سمحة تخفف من وحشتي من مضايقات الراهبات الألمانيات والإدارة بعد أن ارتديت الحجاب في المرحلة الإعدادية .
الفقر المستور
كنت أذهب للمدرسة في صحبة مربيتي التي تسكن في قلعة الكبش بالسيدة زينب والتي تعرفت من خلالها على حواديت تلك المساحات من الفقر المستور الذي طغت عليه بعدها بعقود مظاهر الفقر العشوائي ، وكنا نقطع الطريق عبورا للميدان وانعطافا بجوار مقهى أسترا وسيرا أمام الجامعة الأمريكية ثم مدرسة الليسيه ثم بجوار محطة مترو حلوان ثم بجوار سوق باب اللوق المفتوح ثم المدرسة.
عندما بلغت التاسعة تحررت من صحبة مربيتي فأصبحت أسير في اتجاه إيزائيفتش وأعبر شارع طلعت حرب من ناحية الميدان إلى شارع التحرير من أمام محلات الخردوات والفول والطعمية والأدوات الكهربية ثم أمر من أمام محل "الصيرفي" الذي كان يبيع اللب والسوداني ويقابله على الجهة الأخرى محل تصليح الأحذية الذي كنا نتعامل معه ويملكه جورج وأخيه ، ثم أدلف إلى شارع يوسف الجندي لأصحب زميلة لي في الفصل تسكن في مواجهة باب "المبنى اليوناني" للجامعة الأمريكية، والذي يقع فيه في الشارع محل خردوات "يني" الذي اعتادت أمي أن تشتري منه الخيط والأزرار ، ثم يصب مسارنا في شارع محمد محمود في مقابل مدرسة الليسيه حيث كانت لجان مدرستنا لامتحانات الشهادات (الابتدائية والإعدادية والثانوية).ثم يسارا لطريقنا للمدرسة.
في المرحلة الإعدادية قرر والدي أنه بجانب القراءة يجب أن أتعلم مهارة ما ، فاشترك لي في أحد الأجازات الصيفية في دورة لتعليم الآلة الكاتبة (كان هذا عصر ما قبل ظهور الكومبيوتر الشخصي ثم المحمول) فدخلت مبكراً مساحة الجامعة الأمريكية بكل هيبة الأكاديميا في نفس طالبة الإعدادي، ثم ما لبث أن أرسلني وحدي في الأجازة التي تليها لزيارة أسرة نمساوية صديقة تعيش في فيينا لمدة أسبوع ، فعرفت أن العالم الذي أرى زواره من السائحين الذين يترددون على الميدان لزيارة المتحف المصري عالم واسع لكنه لا يعرف عن عالمنا شيئاً، وفي الصيف التالي استضفنا الإبنتين ردا للضيافة وتجولت معهما فاستكشفت مساحات جديدة من القاهرة القبطية ومواقع لم أزرها لآثار فرعونية وأماكن ومعالم في محافظات خارج القاهرة.
كانت عمارتنا أيضاً بذاتها تعبيراً عن جوار متنوع الثقافات والأديان، فقد كانت الشرفة المقابلة لنافذة غرفتي لجارتنا اليونانية التي تتحدث العربية بلكنة "جريجية" قوية جداً ، وفي الدور الرابع ثلاث أسر لها صلة بثقافات شتى ، فتسكن طنط "ليا" اللبنانية الأصل، وفي الجهة المواجهة لها شقة طنط روز التي كانت تمت بصلة قرابة لبديعة مصابني وكانت إمرأة كبيرة في السن ودودة، ثم في أقصى الطرف شقة محمد بك زكي الذي كان متزوجاً من طنط مارت الفرنسية التي أسلمت وأسمت نفسها ليلى وكانا يعيشان بمفردهما بعد أن ماتت ابنتهما الوحيدة في سن الشباب فكنت أزورهما بين الحين والآخر في وحدتهما ولما بدأت في تعلم الفرنسية في الصف السادس كانت تلك مناسبة للحديث بالفرنسية معهما والتي كان يجيدها "جدو زكي" منذ منحته الدراسية في فرنسا والتي تعرف خلالها على زوجته الرقيقة التي بقيت تهتم بشعرها وتصففه بطريقة كلاسيكية إلى أن مرضت وماتت بعد وفاته هو بقرابة العشرة أعوام، وكنت أسعد حين يطلق يرحمه الله عصفور الكناري من قفصه ويتركه يطير بين الحجرات بعد أن يغلق النوافذ وأبواب الشرفات .
كان اسمه نونوس وكان جدو زكي يناديه بصفير خافت فيحط على رأسه الكبير ذو الشعر الأبيض الكثيف الناعم فيضحك، ثم ما يلبث أن يعود لقفصه وهو يغرد.
في الطابق الثالث كانت تسكن طنط علية التي أسلمت لكن بقيت في كنف أخيها المسيحي لم تتزوج. باقي الجيران لكل منهم قصة سواء من السكان أو من الأطباء، قصص كثيرة ومساحات متراكمة.
مصر الحقيقية
خارج جدران العمارة كانت كل مساحة وسط البلد لي بمثابة الامتداد والمجال الحيوي لمنزلنا، كانت أمي تصطحبني منذ الصغر لشراء الأحذية من محل بامبينو بشارع قصر النيل والذي كان الطابق الأرضي فيه للملابس أما الأحذية ففي الطابق تحت الأرضي فكنا ننزل له بسلم صغير ما زالت أذكره، ولأن أمي كانت تجيد الحياكة، والتي تعلمتها منها، فقد كانت تشتري الأقمشة لكسوة الصيف أو الشتاء من محل سيدتي الجميلة أو محل الشانزيليزيه، وربما من الصالون الأخضر أو نسير حتى نهاية الشارع لمحمد محمود وربما امتد بنا البحث إلى شارع 26 يوليو.
في طريق العودة كنا عادة نقطع شارع عدلي لنمر على المعبد اليهودي ، ويقابله محل بابل في ممر كوداك الذي كان يبيع الأحذية المصنوعة بالطريقة القديمة باليد ذات النعل الجلد الطبيعي وليس أحذية المصانع ، من هناك كان والدي يشتري أحذيته (وكان حين يشتري من الخارج يفضل الأحذية الأسبانية)، ثم نقف عند منفذ بيع فيليبس ، وقد ندلف لشارع شريف لنقف في دار المعارف على ناصية شارع عبد الخالق ثروت نشتري كتب، ونستمر في الشارع نعبر التقاطعات إما نتوجه يسارا لنقف في قصر النيل عند " شالون" نشتري لأخي ملابسه أو لأبي بيجاماته، أو نستمر في شارع شريف حتى مبنى جريدة الأهرام القديم لنشتريها من " ملابس الأهرام.
حين كبرنا وصرنا نتجول في وسط البلد أنا وأخي وأبناء عمي -الذي كان يسكن في عمارة أنور وجدي بشارع هدى شعراوي- في شوارع وسط البلد نشرب الـ"شوكولا جلاسيه" في محل البن البرازيلي أمام سينما مترو ونشاهد الأفلام في سينما وسط البلد، وقد نأكل السندوتشات من " ومبي" في طريق العودة.
لم يكن والدي يصحبني للتجوال في وسط البلد، فلم يكن لديه وقت، إذ كان بعد العمل يعود للغذاء ثم يذهب ليمارس هوايته للتدريب في النادي. المرة الوحيدة التي أذكرها هو يوم اصطحبني وأنا أرتدي فستان أحمر من الكروشيه ليتم تصويري فوتوغرافبا لتقديم أوراق المدرسة.
لم أكن معتادة على الخروج معه دون أمي، وحين ارتديت أجمل فساتيني وعلمت أن والدي هو من سيصحبني أخذتني الرهبة، وأمسكت بيده وأنا وجلة لنسير فقط لآخر الرصيف ، ندلف لشارع طلعت حرب وندخل بعد أن نتجاوز عمر أفندي بعدة محلات إلى " أكتينا" الفوتوغرافي الذي كان يبيع الكاميرات وكذا يقدم خدمة التصوير الأبيض والأسود.
أجلسني والدي على المقعد وقال لي من وراء الكاميرا:" أنظري للعدسة كي نصورك صورة دخول المدرسة". أحسست أن الأمر خطير فجاءت النظرة جادة وصارمة في عين العدسة، وهي الصورة التي حملتها شهادة المدرسة في مرحلة الروضة.
حين استقال والدي من خدمة الشرطة حتى لا يضطر للسفر متنقلاً بين المحافظات كما هي القواعد بعد أن انتهت مهمته في الجوازات- والتي طالت لظروف العدوان ثم الوحدة مع سوريا و حملته لدمشق ضابطاً للجوازات للتدريب لأسابيع، والتي من أجلها استقر نسبياً في وظيفة الجوازات، انتقل إلى العمل الجديد في وزارة السياحة، وكان مكتبه في ميدان الأوبرا.
كنت في أيام الأجازة تحملني قدماي وأنا أتجول في وسط البلد لأشتري أغراضاً أو كتاباً أو أزور زميلاتي اللاتي يسكن في المنطقة أمر عليه في مكتبه، ثم يحلو لي أن أمر بممر الكونتيننتال المغطى الذي كنت أجده فريدا في وسط البلد، ومع مرور الأعوام صرت أذهب أبعد في التجوال إلى ميدان العتبة ثم شارع الأزهر وصولاً للغورية ولجامع الأزهر ومسجد الحسين وخان الخليلي.
حين دخلت الجامعة كانت تلك مسيرتي المفضلة على الأقدام، من التحرير لخان الخليلي صباح الجمعة، أشم رائحة التوابل عند وكالة الغوري تملأ الهواء متسللة من جهة اليسار حيث الشوارع الضيقة تمتلئ بتجار التوابل ، ورائحة البخور أمام المسجد وعند مدخل الصنادقية قبل أن أتجه يميناً للخان وأسير فيه وقد أشتري شيئاً من الحلي الفضية ، وأسمع تلاوة قرآن الجمعة قبل الأذان.
الميدان كان موقعاً هاماً لأنه الأقرب لأرض المعارض، كنا في أجازة نصف السنة نزور معرض الكتاب يومياً، إلى أن تم نقله لمدينة نصر وبناء الأوبرا الجديدة، التي لم نعد نسير لها مشياً بل نركب المترو الذي بدأ مشروع الحفر فيه في عام حصولي على الثانوية العامة 1983 وحرمتنا أعمال الحفر من النوم شهوراً طويلة وأطارت عقل مربيتي التي كلت من تنظيف المنزل آنذاك
تحولات وطن
لكن الذكريات لا تقتصر على ميدان التحرير وحده ،بل لميدان عابدين مكان في الذاكرة، في العيد كنا نقصد في السبعينات الميدان لصلاة العيد، مشهد جليل كان يدير تفاصيله الإخوان، ثم ذات عيد في مطلع الثمانينات أغرقت وزارة الداخلية الميدان بالمياه تماماً ومنعت إقامة الصلاة به وحددت للناس أين يحتفلون وأين يصلون أو لا يصلون..فانتقلنا للصلاة أنا و"أخواتي" من الجيران لمسجد مصطفى محمود، وما زلنا.
مع تقدم العمر وازدحام القاهرة صار التجوال لمسافات في وسط البلد أصعب، لكنني ما زلت أشتري حاجاتي منها، الخردوات من بواباجيان لأن دكان "يني" أغلق أبوابه ، والأحذية أي من المحلات العديدة، فقد كبرت قدمي الصغيرة وحل مكان محل بامبينو متجر أحذية ضخم حديث للكبار، ومكان "سيدتي الجميلة" والشانزيليزيه متجرين لبيع نوع شهير من الملابس الجاهزة غالية الثمن واحد للنساء على اليمين والآخر للرجال على اليسار، ومكان محمد محمود كذلك محل ملابس حريمي له سمعته.
إيزائيفتش حل محله شركة سياحة ومطعم للوجبات الأمريكية، "أسترا" الذي كنت أمر أمامه متعوذة لأنه كان يبيع البيرة صار محلاً للوجبات السريعة الأمريكية (وما زلت أتعوذ)، و "زد" صار محلا لبيع البيتزا، والصيرفي صار محل ملابس وجورج غير نشاطه ليصبح محلاً لبيع الأحذية.
شهدت عبر السنوات تحول الميدان من العالمية للعولمة، اختفى مشهد الأهرامات التي كنا نراها بزاوية في الأفق أيام كان فندق سميراميس القديم قائماً، حجب المشهد عنا بناء سميراميس إنتركوننتنتال الحديث ، وبعد أن كان المشهد هو ميدان به نافورة ومساحات خضراء تم إزالة النافورة بدعوى تجديد الميدان ثم تمت محاصرة المساحة الممتدة أمام الجامعة العربية والهيلتون والمتحف بسور ومنع المشاة من الدخول من جهة شارع ميريت باشا وتحول المربع المغلق لمكان مهمل أجرد قبيح بعد الحادث الإرهابي أمام المتحف منذ سنوات ، تقف بأحد جهاته عربات الأمن المركزي تحسباً لأي خطر..أو مظاهرة .
وسط البلد لم تعد أيضاً مكان التسوق المركزي للطبقة الوسطى كما في الماضي، مع اتساع القاهرة نشأت أمكنة التسوق والتي بدأت بسور نادي الزمالك وتوسع ميدان روكسي ثم تغولت بظهور المولات كمساحات مغلقة لا ترى الشمس، ولكن ذلك لم يفقدها الجمهور المتنوع الذي ما زال يتجول في شوارع المنطقة ولا نقاطها المركزية: مكتبتي الشروق ومدبولي والمكتبات المتناثرة الأخرى، البنوك المركزي والأهلي وبنك مصر، السينمات التي يقصدها الشباب في وسط البلد، مقهى ريش والنادي اليوناني (مساحات أصدقاءنا من اليسار)، دار القضاء العالي وحديقة الأزبكية، والأرصفة الطويلة المتقاطعة التي تجعل للتسكع مذاقاً خاصاً ، ناهيك عن مركزية وسط البلد للحركة الاحتجاجية من" كفاية" لجبهات التحالف الأخرى في ميدان طلعت حرب وأمام نقابتي الصحفيين والمحامين، بل صار من معالم وسط البلد عربات الأمن المركزي بجوار جروبي تحسباً لمظاهرات حزب التجمع وحزب الغد.
ما زال يحلو لي أن أجلس في شرفة منزلنا ليلاً أو فجراً، تلمع أضواء القاهرة أمامي، وأنظر للميدان الخالي من زحام وضجيج النهار، أذكر أبي الذي كان يحب الشرفة ويجلس ليتأمل فيها مساءاً حركة الناس، وأسترجع ذكريات الطفولة والصبا والشباب، بقي الميدان بمعالمه الرئيسية، لكن مات الكبار وتحولت الكثير من الشقق لشركات سياحة ومكاتب مقاولات حتى لم يبق في العمارة سوى عشر شقق سكنية من أصل 39، والباقي أغلبه تتغير نشاطاتها كل عدة أعوام بحسب المستأجر للمكان، يذهب الناس ويجيئون، تتغير الوجوه وتتحول طبيعة المكان.. وما يغيب عن العين تحفظه الذاكرة فتتقاطع مشاهد الطفولة مع مشاهد الواقع، وتتماهى، فأتواصل مع المكان بمستويات وعي متعددة.
من هذه الشرفة المطلة على الميدان سمعت صفارات حرب الاستنزاف وأنا ابنة الأعوام الثلاث، وشاهدت الناس في مجموعات تعبر الميدان تبكي في طريقها لجنازة عبد الناصر بعدها بعامين وطالعت الميدان أيام حظر التجول يعد انتفاضة الخبز في السبعينات، ثم راقبته خالياً يعد أحداث الأمن المركزي في الثمانينات، ومزدحماً يوم ضرب العراق في مظاهرة لم يشهد الميدان مثلها، ومن بعدها صار ميدان التحرير محتلاً بالأمن لمنع المظاهرات والاحتجاجات.
كان الزمن يغير مساراته والقاهرة تستبدل أثوابها ..وكان هذا الميدان الفسيح مساحة.. وأفق ..ومرآة لتحولات الوطن.. والذات، ومرتكزاً للوعي ..والذكريات .. ثم صار اليوم مشهدا فارقا في تاريخ وطن..وأمة.
د. هبة رؤوف عزت
أستاذ العلوم السياسية – كلية الأقتصاد – جامعة القاهرة
heba.raouf@gmail.com

