 | |  | | | عايش فى «صندوق قمامة» 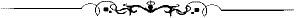

| فى عالم جمع القمامة .. ترى إلى أى مستقبل ينظر؟! |
بقلم الشيماء عزت
من شوارع «عين الصيرة» إلى «المدبح»، يبدأ يومه، عندما ينام الآخرون، فى الثالثة من صباح كل يوم يدفن رأسه الصغير فى الصندوق الرمادى الكبير، ويظل دقائق ملحوظة يفتش ويقلّب ويثير جَلَبة محدودة بحجم كفيه الصغيرتين، لا يفكر فى أنه بداخل صندوق ضخم من القمامة وفضلات البيوت والمحال،
ولا يهتم بمظهره الذى تدلَّى فيه نصفه العلوى داخل الصندوق بينما ترنحت قدماه تحاول اللحاق برصيف الشارع، ولا يكترث بالرائحة التى دسَّ فيها أنفه فى الوقت الذى يبتعد فيه المارة عنها أمتارًا،
يخرج سعيدًا حاملاً أربع عبوات مياه غازية «كانز»، ،تعلو وجهه ابتسامة مَنْ حصل للتوّ على أرفع شهادات التقدير، يقفز على ظهر عربته الكارو ويغنى لحماره أغنية من تأليفه ليحايله على السير للصندوق الذى يليه.
هكذا يبدأ يوم «إبراهيم»، يصحو عندما ينام الآخرون، يعمل حيث يتركون فضلاتهم، ينهى عمله قبل أن يبدأوا يومهم التالى، بعد أن يكون قد حمّل ظهر حماره بعشرات الزجاجات البلاستيكية الفارغة والصناديق الكرتونية الممزقة، وإذا حالفه الحظ، وألقى فى طريقه بعض عبوات الكانز يكون قد اطمأن إلى أن يومه سيكون سعيدًا.
على ناصية شارع الفرن بمنطقة الزرائب فى حى «منشأة ناصر»، دخل إبراهيم فخورًا مزهوًا بنفسه بعد أن نجح اليوم فى جمع ما يقرب من 15 علبة كانز، وعدد لا بأس به من عبوات الشامبو الفارغة، لم يفسد عليه فرحته وفخره سوى ابتسامة تلقاها من طفل صغير فى مثل عمره جلس بجوار والده فى سيارته الخاصة، وفى يده استقرت قطعة شيكولاته أخذ يأكلها باستمتاع بدا على وجهه، بملابسه النظيفة وشعره المهذب وبراءة لم يفسدها العمل فى سن صغيرة، نظر إلى إبراهيم وابتسم، وسواء حملت الابتسامة عطفًا أو سخرية للطفل الجالس فوق الحمار فالأهم أنها أعادته إلى يوم هروبه من المدرسة، ورن فى أذنيه صوت والده يقول: «ما تروحش المدرسة تانى.. فلوس ع الفاضى ومافيش تعليم»، واستشعر فرحته بقرار والده فانتشى ثم عاد ليتذكر أول يوم عمل: «مش قادر أستحمل الريحة دى يا بوى».
وبنظرة حازمة من والده ولطمة على القفا من «مينا» أخيه الأكبر: «بلاش دلع ياد.. استرجل»، عاد إلى رشده وأدرك أن مصيره تحدد ولا مفر من أكوام القمامة. لم يحلم إبراهيم يومًا بأن يصبح طبيبًا أو مهندسًا أو حتى ضابطًا، لذا فقد هرب من ذكرياته الأليمة بسرعة وابتعد عن ابتسامة الصغير ليدخل حدود منطقته التى لن يعايره فيها أحد بعمله، فالكل هناك سواء.
على باب مدرسة إعادة التدوير، التابعة لجمعية جامعى القمامة، استقبله «سمعان»، أقرب أصدقائه، بضحكة بريئة علت وجهه الأسمر قال: «رجعت بدرى.. شكلك مجبور»، قفز إبراهيم من عربته وأنزل «شوالاً» مملوءًا بزجاجات الشامبو كان قد فرزه أثناء رحلته، ناوله لسمعان: «دخّل الجوان ده المدرسة.. هاروح أغير وأجيلك»، ثم عاد إلى حماره بقفزة معلم واتجه نحو المنزل.
الطريق من المدرسة للبيت ليس طويلاً، لكن تملؤه التفاصيل، وجوه الناس فى الشارع التى حفظته كما حفظها، بعضهم ينظر إليه ليعد مكسبه فى عجلة مع كل «شوال» يحمله على عربته، والبعض الآخر يلقى عليه سلامًا باردًا بينما ينهمك فى فرز أكوام الزبالة التى أمامه، رائحة الشارع أسوأ من رائحة الصندوق الذى كان بداخله، والبيوت تكدست أدوارها الأولى وأسطحها بأجولة القمامة المفروزة، نفس الحياة ونفس الرائحة ونفس التفاصيل يتركها إبراهيم فى ساعات الصباح الأولى ويعود ليجدها كما هى فى الحادية عشرة صباحًا حيث ينهى عمله..
النساء والرجال والأطفال فى «منشأته» يعملون فى القمامة ويعيشون وسطها ويلعبون بها، ولا ينظرون إلى العالم خارج حدود منطقتهم إلا عبر صناديق القمامة.
فى المنزل ألقى «هيما» حصاد يومه بجوار أكوام القمامة المرصوصة والمفروزة بعناية فى المدخل، ألقى التحية على جده العجوز الذى أفنى عمره فى جمع القمامة وتقاعد بفعل المرض، وأخذ يقرأ عليه تعاليم الإنجيل بتباهٍ وتلعثم شديدين، فهو الوحيد فى أسرته الذى تعلم القراءة والكتابة،
ويعترف الجميع- خصوصًا جدته- بأن «هيما مخه نضيف وأكتر من مينا مع إنهم فى مدرسة واحدة»، داهمه الوقت فبدل ملابسه بسرعة واستعد للذهاب إلى المدرسة، على الباب قابل عمه فى سيارته نصف النقل الجديدة التى يحملون عليها القمامة لبيعها بدلاً من العربة الكارو، التى كانت متاعبها كبيرة بعد أن ضيقت عليهم الحكومة فى التحرك بها، باع عمه الحمار أملاً فى راحة ورزق أوفر إلا أنه لم ينقطع بعدها عن ترديد مقولته الشهيرة «مافيش أحسن من الشغل مع الحمير»، كان عمه متذمرًا اليوم أكثر من كل الأيام «3 غرامات النهاردة بـ300 جنيه على الصبح..
هو أنا شايل بضاعة بنصفهم؟!»، الشكوى التى تتكرر كل يوم تزداد مع زيادة الغرامة وحمولة السيارة، حزام الأمان، والسير فى غير الأماكن المخصصة، وعدم الالتزام بتعليمات المرور هى أسباب الغرامات التى يؤكد أنه يدفعها «فِرْدة» دون مبرر أو مخالفة تستحق، بجانبه مر «هيما» وبنبرة استفزازية قال: «مش الحمار كان أصيل.. هى دى آخرة البطر»، ثم فر هارباً إلى المدرسة متفادياً لكمة قوية من عمه الثائر.
«نفسى أجيب ماكينة تكسير وأشتغل حر وأبقى ملك الزبالة»، حلم إبراهيم صغير مثله لا يتعدى حدود منطقة الزرائب التى يعيش فيها، ولا عمله الشاق، ولا ينقذه من الرائحة الكريهة ولا القمامة، لكنه يتصور أن فيه متاع الدنيا، يحلم به كل يوم ويتمسك به أكثر وأكثر مع كل «شخطة» من صاحب محل أو ربة منزل «امشى يا واد من هنا»،
يشاركه فى الحلم سمعان، الذى يحب أن يناديه «نونه»، والذى يحاول بكل الطرق إثناءه عن حلمه خوفاً من أن ينتهى به الحال كـ«وِلْد شحاتة» الذى راح ضحية ماكينة تكسير ولعبة استغماية، اختبأ خلالها داخل الماكينة وبضغطة خاطئة على مفتاح التشغيل راح أشلاء، إلا أن محاولات «نونه» دائماً ما تضيع هباء عندما يرد عليه هيما بإقناع:
«أنا مش هاشتغل عليها بنفسى أنا هاشغّل صنايعية»، ثم يكرر «نونه» محاولاته مجدداً، شارحاً له حال سوق الزبالة والانهيار التى شهدته فى الآونة الأخيرة بعد أن انخفض سعر طن الكرتون من 350 جنيهًا إلى 170 جنيهًا فقط، فيرد هيما متمسكاً بحلمه: «الكانز والباغ والجزاز لما بتتكسر أى واحد يستمنى يشتريها»،
وعلى الرغم من أن المكسب الذى سيجنيه إبراهيم من وراء حلمه بسيط جداً لا تتعدى الزيادة فيه عن مكسبه الحالى سوى بضعة جنيهات إلا أنه يرى فيه العزة والكرامة والعمل الحر، لم يحلم يوماً بغيره باستثناء حلم راوده عندما التحق بمدرسة إعادة التدوير سرعان ما تراجع عنه، وهو أن يصبح «أستاذ ع العيال».
فى المدرسة يتعلم كل شىء، الكتابة، والقراءة، والعمل على الكمبيوتر، وطرق فرز القمامة، وتكسيرها وإعادة تدويرها، يتخصص فى جمع علب الشامبو، ويرى فى عمله غاية نبيلة هى حماية الماركات العالمية من التقليد، يتفاخر بأنه تعلم فى مدرسة إعادة التدوير التى تتوسط أرضًا فضاء تحيطها مقالب القمامة من كل جانب ما لم يتعلمه فى مدارس «الحكومة»، يرسم ويغنى ويلعب ويعمل مع زملائه من أبناء الزبالين، ويحكى لهم عن مغامراته فى جمع القمامة:
لم يضربنى أحد فى حياتى سوى مرتين، وبكيت مرة واحدة فقط عندما شتمنى أحدهم «يا ابن الكلب». باستثناء هذه المرات يؤكد «هيما» أنه صاحب سيطرة فى كل الأماكن التى يعمل بها، هناك من يعطف عليه لأنه «عايز ياكل عيش»، وقليلون من ينهرونه و«يبلطجوا» عليه، لكنه تعلم كيف يعاملهم دون أن يتعرض لإهانة.
فى السابعة مساء ينتهى يومه الدراسى، يمشى بخطوات صغيرة فى الشارع يتأمل الناس على المقاهى والأطفال الذين يحملون أعقاب السجائر المشتعلة، ويخبئون الأمواس الحديدية بين الشفة والأسنان، تحسباً للخناقات العنيفة، يبتعد عنهم لأن أباه نبّه عليه ألا يخالطهم، يحرص أن يكون نظيفاً أثناء خروجه من المدرسة رغم أظافره التى يحشوها الوسخ، لكنه يبرر لنفسه ذلك بأنه «لزوم الشغل»، فتقشير المطبوعات من على زجاجات الشامبو شرط من شروط الفرز..
يتذكر ميعاد صحوه فيسرع إلى المنزل طمعاً فى دقائق معدودة يلعب خلالها بعجلته الجديدة التى اشتراها من «حر ماله» بعد أن كافأه والده عندما جمع عددًا لا بأس به من زجاجات الكانز، «عجلة صغيرة لكن هابيعها واشترى واحدة كبيرة»، ولأن إبراهيم ليس ككل الأطفال التى تلهو وتلعب متى تشاء، ألقى نظرة سريعة على برامج الكارتون فى الفضائيات عبر وصلة الدش، وساقته قدماه إلى السرير مرهقاً فى تمام التاسعة، لينتظر صوت والده فى الثالثة صباحاً يتنحنح معلنًا بدء العمل و«زغدة» شريرة من مينا تعلن بداية يوم جديد وسط أكوام القمامة
06/11/2014
مصرنا ©
| | 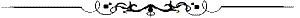
| | |
| |  | |  |
|
|

