نماذج من الفكر العقلاني التنويري والنهضوي العربي
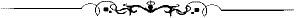
 | |
الحبّوبي | |
بقلم : فتحي الحبّوبي
......................
«...والأدلّة، ثلاث: دلالة العقل، لأنّه يميّز بين الحسن والقبيح، ولأنّ به يعرف أنّ الكتاب حجّة، وكذلك السنّة والإجماع. وربما تعجّب من هذا الترتيب بعضهم، فيظنّ أّنّ الأدلّة هي: الكتاب والسنّة والإجماع فقط، أو يظنّ أنّ العقل إذا كان يدلّ على أمور فهو مؤخّر، وليس الأمر كذلك» من كتاب “فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة” للقاضي عبد الجبّار بن أحمد، طبعة تونس 1972 . لعلّه من نافل القول التأكيد على أنّ إشكاليّة التخلّف المزمن وفشل، محاولات النهضة العربيّة التي تعاني من جرّائها المجتمعات العربيّة اليوم، سواء منها تلك التي عاشت ربيعها الثوري أو التي لم تعشه، ليست وليدة الصدفة، بل هي نتيجة مراكمة مواطن خلل عديدة وأخطاء كثيرة، ليس في المقاربات المفاهيميّة للتنمية و محدوديّة وقصور مناويلها في مستوى التشغيل و العدالة الاجتماعية بين الفئات والجهات فحسب ، بل وكذلك كافراز لرؤى فكريّة ومتبنّيات، منها ما يتّصل بالمقدّس بما هو ادّعاء بامتلاك الحقيقة الربّانية المطلقة واعتناق لمعتقدات في غير ما اعتماد للعقلانيّة في شأنها، ومنها ما يتّصل بالزمني بما هو دنيوي مادّي/ مخلوق.
حيث أنّه، كلّما قامت في المجتمع العربي الإسلامي حركة فكريّة نقديّة تنويريّة و إصلاحيّة تؤمن بأّنّ العقل هو المعيار الرئيسي في فهم كل القضايا ذات العلاقة إن بالدين أو بالدنيا وسعت لبثّ الوعي، وتحريض العقل العربي على الإشتغال تجنّبا للتعطّل والجمود والتكلّس، إلاّ وكان –قطعا- مآلها الضُمورَ و النكوص ثمّ التلاشي.
ضمن هذا السياق، فإنّي أزعم أنّ العصر الوسيط للمسلمين، الذي يتوافق تقريبا مع العصور الوسطى للغرب الأوربي التي عرفت فترة ركود وظلام ، تميّز بمحاولتين للنهوض الفكري بالعالم العربي الإسلامي. فأمّا المحاولة الأولى فكانت على يد فرقة المعتزلة رائدة العقلانيّة في الفكر الإسلامي، التي تؤمن بتأسيس الدّين على العقل، فتجعل منه أقوى الأدلّة وتنصّبه حكماً في أمور الدّين والعقيدة. وقد إشتهرت كمدرسة كلاميّة بموقفها المخالف لموقف عموم المسلمين في قضيّة مرتكب الكبيرة الذي اعتبروه كافرا، فيما أقرّ المعتزلة بأنّ منزلته هي بين منزلتي الإيمان والكفر. كما اشتهرت كتيّار فكري حرّ ظهر مبكّرا منذ بداية القرن الثاني للهجرة، في مدينة البصرة- أحد أهمّ المراكز الفقهيّة والفكريّة والأدبيّة- ووقع التصدّي له ورفضه بقوّة وتربّصوا به الدوائر باعتباره يقوم في جوهره على اعتماد العقل في شرح وتفسير العقائد الإسلاميّة إنطلاقا من نصوص الكتاب والسنّة. بل أنّ المعتزلة يقدّمون العقل أحيانا على النصّ كما جاء في كتاب "في فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة" للقاضي عبد الجبّار بن أحمد.
وفي تقديري فأنّ رفض الفكر المعتزلي يتضمّن بعدين هامّين يستحقّان منّا الوقوف عندهما وإن بطريقة عَجْلَى. أوّلهما أنّ بيئة و ذهنيّة المجتمع العربي حديث العهد بالإسلام آنذاك، تطمئنّ أكثر إلى الإجماع حول الرأي المتشدّد/المتصلّب، فيما لا تؤيّد حقّ الإختلاف في الرأي، لا سيّما إن كان لحساب الفكر التنويري المؤمن بأولويّة العقل على النصّ الديني وليس بأولويّة النصّ على الواقع بما هي أولويّة للدّين على الدنيا. وثانيهما أنّ التكفير الذي نعاني اليوم من نتائجه الكارثيّة المدمّرة في كل مكان من العالم العربي والإسلامي متجذّر في ثقافتنا منذ البدايات. لذلك، فرغم أنّ الفكر المعتزلي كان في عهد الخليفة المأمون هو المذهب الرسمي للدولة وتأثّرت به تيّارات فكريّة أخرى لها النزعة التحرّريّة ذاتها، فإنّ المعتزلة العقلانيين قد واجهوا، لاحقا في عهد الخليفة المتوكّل، المعتنق للمذهب الأشعري الجبري اللاعقلاني الذي ينفي مكانة العقل ويلغي دور وفعل الإنسان وكذلك حريته في رسم مسار حياته، ولو في الحدود الدنيا. واجهوا صدّا ومقاومة شديدة من قبل ذوي الفهم الفقهي النقلي المتخلّف للإسلام، الذين يؤمنون بمقولة القسر والجبر. وهي المقولة التي يكون بمقتضاها الإنسان مسيّرا وليس مخيّرا ومسؤولا عن اختياره الحرّ. وكان من نتائج ذلك أن قتل من المعتزلة من قتل وعذّب من عذّب منهم، إلى أن اندثر تيّارهم الفكري العقلاني المستنير الحرّ الذي سبق الفكر التنويري الانجليزي الالماني الفرنسي بحوالي عشرة قرون. ولو قدّر للمعتزلة الإستمرار في نشر طروحاتهم الفكريّة، التي تتمحور بالأساس حول فكر يقوم على حريّة الفرد، وينظر إلى الإنسان باعتباره غاية الوجود و صاحب الإرادة والاختيار، لأسهموا بفعاليّة في إحداث نهضة المجتمع العربي بالفكر العقلاني النقدي الذي يعضده العمل الجاد باعتبارهما يمثّلان عصب كل نهضة وقطب الرحى لكل تقدّم في أيّ مجال كان. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن بفعل العقليّة العربيّة الشرقيّة وبنيتها التي تركن إلى السائد وتقاوم المختلف ولا تشجّع على النجاح. وهو ما عبّر عنه الدكتور أحمد زويل المتحصّل على جائزة نوبل عندما قال:« الغرب ليسوا عبآقرة .. ونحن أغبيآء !! ھٓم فقط يدعمون الفآشل حتى ينجح ..! ونحن نحارب الناجح حتى يفشل .. »
وأمّا المحاولة الجادّة الثانية للنهوض الفكري بالمجتمعين العربي والإسلامي، فكانت على يد الفيلسوف الأندلسي ابن رشد، عبر إنتاج منظومة فكريّة عقلانيّة مستنيرة بخاصيّات قريبة من منظومة الفكر المعتزلي، بل إنّها تكاد تتماهى معها في بعض التفاصيل. إذ أنّه سجّل موقفا متميّزا من قضيّة العلاقة بين الدين والفلسفة من خلال كتابه (فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال). حيث يقول-في تعارض صارخ مع أبي حامد الغزالي، أحد أكبر المتسبّبين في تخلّف المسلمين - أن « لا تعارض بين الدّين والفلسفة، وإذا كان هناك من تعارض فالتعارض ظاهري بين ظاهر نصّ ديني وقضيّة عقليّة ونستطيع حلّه بالتأويل…». ومن هذا المنطلق، فهو يرى أن الشرع أوجب ليس فقط النظر بالعقل في الوجود بل أوجب كذلك دراسة المنطق. ويرى أيضا «أنّ القضايا البرهانيّة العقليّة هي حقّ، وما نطق به الشرع حقّ، والحقّ لا يضاد الحقّ بل يؤكّده ويشهد له». بما يعني أنّ الحكمة (الفلسفة) والشريعة (الدين) لا يتناقضان كما ذهب الغزالي إلى ذلك في “تهافت الفلاسفة ” الذي شكّل في تقديري تكريسا للإنغلاق ومصادرة للرأي الآخر وسقوطا في ما يسمّيه أفلاطون "الميزولوجيا"، بما هي "كراهية العقل" . لذلك يمكن الجزم بما يشبه اليقين، أنّه بموت إبن رشد انتصرت -وياللأسف- مدرسة النقل لزعيمها أبو حامد الغزالي، ثانية ونهائيّا، على المنهج العقلي الذي خبا تأثيره بعد أن مثّلته مدرسة الإعتزال ومنظومة ابن رشد الفكريّة التي كاد بمقتضاها أن يؤلّه العقل رغم تديّنه الشديد. وكان من تداعيات ذلك، أفول الفلسفة الإسلاميّة و بداية تخلّف وانحطاط العالم العربي والإسلامي الذي لا يزال متواصلا إلى اليوم على طريقة السقوط الحرّ -في الفيزياء- وعلى جميع الصعد. فلم يعد المسلمون فاعلين في بناء الحضارة الإنسانيّة، لابل و استسلموا لنوم عميق، ما زالوا يغطّون فيه إلى اليوم، وربّما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمن يدري؟! أليس "الجلوس على الربوة أسلم" لمن لا يريد خوض المعارك الفكريّة والتجارب العلميّة، ويستمرأ الكسل ويفضّله على العمل والجهد المنتج، فيبدّد طاقته وينفق وقته فيما لا طائل من ورائه؟! كالتغنّي بأمجاد الماضي التليد من باب التوكؤ عليه وتصوير السلف على أنّه صالح على بكرة أبيه لا تشوبه شائبة، لا بل على أنّه معصوم ويدنو من الملائكة من باب تقزيم الحاضر ولعن المستقبل ليس إلّا. و هو ما لا يستقيم عقلا ولا يمكن القبول به نهائيّا. لأنّ الإنسان، إنسان بخيره وشرّه، في كلّ زمان و مكان. فقد خلق الله الإنسان حراً ليجرّب الشرّ والخير والخطأ و الصواب ، والكفر والإيمان. لذلك جاء في الآية الكريمة: « فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ ». و لعلّ في إنقلاب الصحابي معاوية وهو من السلف "الصالح" على مبدأ الشورى في الخلافة و الإستعاضة عنه بالملك العضوض، حيث أكّد على ذلك في أوّل خطبة له « إني والله ما قاتلتكم لتصلّوا ولا لتصوموا، وإنّما قاتلتكم لأتأمَّرَ عليكم ، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون » ، وكذا أمره بلعن علي بن أبي طالب على المنابر، عبرة بليغة لمن يعتبر، سنّة وشيعة، ممّن يقدّسون السلف "الصالح" حدّ الهوس.
وأمّا في العصر الحديث والمعاصر، وانطلاقا من منتصف القرن التاسع عشر، فإنّ محاولات النهوض الفكريّة والحضاريّة التي مثّلت تقديم إجابات عن تحدّيات العصر من أجل تقدّم الاّمة العربيّة ونهضتها، قد إتّسمت بالكثرة والتنوّع. وكان بروز المشاريع الإصلاحيّة الأولى على يد رفاعة الطهطاوي مؤسّس حركة النهضة في مصر وخير الدين باشا رائد النهضة العلميّة في تونس، ومؤلّف أوّل موسوعة عربيّة/دائرة المعارف وفق المنهج الحديث، وهو بطرس البستاني في لبنان، صاحب شعار" الدين لله والوطن للجميع". وكانت هذه المشار يع في عمومها تسعى لفصل الدين عن السياسة وإفراز مجتمع مدني شبيه بالمجتمعات الأوروبية، تفُكُّ فيه الدولة عنْ نفسِهَا قيدَ الدِّينِ دون التخلّي عن الهويّة الإسلاميّة. بحيث يكون الإسلام في المجتمع كعقيدة دينية ليس أكثر. بما ينسجم مع ما قاله -لاحقا- قائد النهضة في ماليزيا مهاتير محمّد «عندما أردنا الصلاة إتّجهنا صوب مكّة، و عندما أردنا بناء البلاد إتّجهنا صوب اليابان ». وعلى صعيد آخر برزت محاولات التجديد و الإجتهاد الديني التي قام بها كلّ من جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا. وقد سعت بجدّ لتصحيح الرؤية التقليدية للدين التي غالبا ما كرّست الجمود. وذلك من خلال إعادة صياغات جديدة للمبادئ الإسلاميّة الكبرى ذات الطابع الاجتماعي في محاولة لإفراز مجتمع مدني مرجعيّته الشريعة الإسلامية، يتصدّى إلى الدعوات التغريبية ويقف في وجه الهجمة الحضارية الغربية التي بهرت الأبصار وأخذت العقول.
ضمن هذا الحراك الفكري يعتبر رفاعة الطهطاوي (1801 - 1873) ، أحد أهمّ الدعائم الفكريّة التي قامت عليها النهضة في مصر، أوّل مفكّر عربي معاصر طرح سنة 1834 في كتابه الشهير "تخليص الابريز في تلخيص باريز" ، الذى تتجاوز أهميته حدود عصره، طرح الإرهاصات الأولى للإصلاح ومنها فكرة الحريّة كسبيل للتقدم، ينظر لها ليس فقط باعتبارها تكرّس المفهوم الإسلامي للعدل والإنصاف وتتوحّد معه، بل وكذلك وبصفة خاصّة، باعتبارها من أهمّ أسباب نهضة الأمّة وتمدّنها المنشود. وهو الطرح الذي يفترض محاولة التوفيق بين الأحكام الشرعيّة الإسلاميّة و القوانين الوضعيّة سليلة الحضارة الغربيّة الحديثة. كما يفترض محاولة التوفيق في ذات الوقت بين الولاء للأمّة الإسلامية في كلّيتها واحترام خصوصيات القوميات/ الأقلّيات غير المسلمة التي تعيش ضمن المجتمع الإسلامي. و هذا الطرح يتماهى بالتأكيد مع مفهوم الدولة المدنيّة الديمقراطيّة التي يشكل التعايش الآمن الناتج عن حريّة المعتقد أحد مرتكزاتها الأساسية و تمظهراتها في آن معا .
ويمكن إختصار مقاربة رفاعة الطهطاوي لتحديث المجتمع المصري في ،نظرته إلى الحكم باعتباره يرمي إلى خير أو سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة في ذات الوقت. وأن سعادته في الدنيا تقتضي توفّر حضارة مدنية كالتي قامت في أوروبا الحديثة ذات القوة والعظمة، بفضل تشجيعها على تنمية مختلف العلوم والفنون والآداب. بما يحتّم الإقتداء بها دون التفريط في الأصالة العربيّة الإسلاميّة. لذلك فإنّ الطهطاوي، الذي نادى بضرورة التطوّر و إرساء الديمقراطية والحكم الدستورى وإشاعة التعليم، بما في ذلك تعليم المرأة ونشر العلم ، تتطرّق للمفاهيم الفكرية الاساسيّة التي قامت عليها الدول الحديثة والمتقدّمة، التي من بينها مبدأ المواطنة الذي وصفه بأنّه «المنافع العمومية التي تقوم على الحرية والإخاء والمساواة بين أبناء الوطن الواحد».
ورغم أنّ طهطاوي ، باعتباره رجل سياسة ونفوذ ، قد حاول وضع بعض أفكاره موضع التنفيذ بإنجاز مشاريع ذات طابع علمي لعلّ من أهمّها إنشاء مدرسة الألسن، إلّا أنّ قدر هذه المحاولة كان- هو الآخر- العرقلة والإجهاض من قبل السلطة في عديد المحطّات التاريخيّة.
أمّا خير الدين باشا المعروف في المشرق بخيرالدين التونسي (1825-1889 ) فيعتبر هو الآخر أحد أعلام النهضة والتنوير في تونس، بل هو أبرزهم تاريخيا ومن حيث المساهمة- نظريّا وعمليّا- في بناء نهضة تونس الحديثة. حيث أنّه لم يكتف ببثّ روح اليقظة والنهوض في الأمّة وشحذ عزائم الإصلاح عن طريق نشر الفكر فحسب، بل إنّه طبّقه على أرض الواقع فأنشأ سنة 1875، باعتباره رجل سياسة ونفوذ، المدرسة الصادقيّة لتعليم الفنون والعلوم الحديثة ونظّم مؤسسّات الدولة تنظيما حديثا، ضمن خطة شاملة للإصلاح تدعو فيما تدعو إليه، إلى توسيع مجال السياسية الشرعيّة ليشمل كل ما لا يخالف الكتاب والسنة، وعدم حصرها على ما ورد في شأنه نصٌّ قرآني أو حديث . أمّا عصارة أفكاره التي وفّقت بين الفكر الليبرالي القائم على الحكم الدستوري والحريّة الإقتصاديّة والتقاليد الإسلاميّة فقد تضمّنها كتابه الخالد " أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك " الصادر 1868، وهي السنة ذاتها التي ظهر فيها الجزء الأوّل من كتاب "رأس المال " لكارل ماركس منظّر الفكر الشيوعي. وقد لمسناه فيه-كما الطهطاوي- متأثّرا بما شاهده في فرنسا من معالم نهضة حضاريّة وفكريّة واجتماعيّة وسياسيّة. فهو يؤكّد ضمن مقدّمة الكتاب، الذي دعا فيه معاصريه إلى الإستعارة من الغرب من أجل الارتقاء بالأمة، أنّ الحكم المطلق الشمولي لا يؤدّي إلّا إلى التخلّف المزمن. وأنّ لا خوف على المسلمين إن هم اقتدوا بالحضارة الأوروبية، وأن لا غضاضة في اعتماد النظم الأوروبيّة في المجالات السياسيّة و الإجتماعيّة و الإقتصاديّة لأنّها لا تتعارض في جوهرها مع النظم الإسلاميّة. بل إنّها تتوافق معها بشكل يكاد يكون كلّيّا .وكلّ نظام له ما يقابله في الدولة الإسلاميّة. فالوزير المسؤول أمام الأمّة/الشعب في أوروبّا، إنّما يقابله الوزير الصالح في الإسلام الذي يسدي النصيحة ولا يخشى في الحقّ لومة لائم. أمّا نواب البرلمان فيقابلهم أهل الحلّ و العقد. وأمّا الحكم النيابي وحريّة الصحافة فيقابلهما مبدأ الشورى. ويخلص خير الدين باشا بعد ذلك إلى أنّ استلهام النظم الأوروبية ليس سوى تنفيذ لروح الشريعة الإسلامية ومقاصدها انطلاقا من مبدأ "المصلحة" لابن قيم الجوزية. وهو ما جعله ينادي بأن تؤسّس الدولة على دعامتي الحرية والعدل وتعدد مؤسسات الحكم و مشاركة "الرعايا"/المواطنين في إدارة شؤون الدولة واحترام حقوقهم الإنسانية ، ملحّا على توفّر وعي الأمّة واستنارتها لتطالب بحقوقها ولتضمن مراقبة دواليب الحكم لتجنّب الاستبداد والانفراد بالحكم الذي يؤدّي بالضرورة إلى التفريط في الحقوق . يضاف إلى ذلك مناداته بحرية "المطبعة " بما هي حرية للرأي والكتابة والنشر وركن أساسي في إرساء الديمقراطيّة.
ومثلما عرقلت محاولة طهطاوي فإنّ محاولة خير الدين باشا عوّقت من قبل المعارضين للإصلاح وخاصةّ منهم باي تونس /الملك الحاكم.
ورغم أنّ خير الدين باشا لم يحقّق مراده من الإصلاح إلّا أنّه ترك بصمته الإصلاحيّة الواضحة في المجتمع التونسي الذي أصبح في موقع المركز، على الأقل، من حيث المساواة بين المرأة والرجل ومن حيث انطلاق الثورة العربيّة الراهنة وتثبيت مسار ودعائم الحكم الديمقراطي رغم المعوّقات الظرفيّة الكثيرة والإنفلاتات.
وما يمكن الإشارة إليه في النهاية، أنّه رغم أنّه قد برز إلى السطح في العالم العربي فكر تنويري وإصلاحي، إلّا أنّه لم يمثّل حركة تنويرية إصلاحية جذريّة كإفراز لمنظومة فكريّة متكاملة تحمل مشروعا واضح المعالم و تمثّل مرجعيّة صلبة كما حدث في أوروبّا خلال القرنين السابع والثامن عشر بفضل لفيف من فلاسفة التنوير الغربيين الذين جمعهم هاجس القطع مع النظم السائدة والدفع إلى صياغات لفكر ونظم جديدة. بينما ما جمع بين المفكرين المعاصرين العرب التنويريين إنّما كان مجرّد ردّة فعل على مشاريع التغريب أكثر منها إبداع فكر جديد.
06/11/2014

