نعوم تشومسكي
معالم النظام العالمي
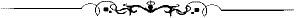
الهيمنة عدم الاستقرار و رهاب الأجانب في عالم متغير
نص محاضرة ألقاها في ويستركيرك, أمستردام , هولندا
 | |
تشومسكي | |
ترجمة : عزة حسون فريق الترجمة خارج السرب
عندما استقرينا على عنوان هذا النقاش قليلون هم من خمّنوا أنه سيكون مفيداً لاحقاً, و كم سيتغير العالم بشكل كبير و حجم العواقب الكبيرة التي سيحملها هذا النظام على النظم المحلية و العالمية. كانت حركة الديمقراطية المتصاعدة في العالم العربي عرضاً رائعاً للشجاعة و التفاني و الالتزام من قبل القوى الشعبية, و هذا توازى أيضاً و بشكل لافت مع التمرد الواسع لعشرات الآلاف ممن يدعمون حركة العمال و الديمقراطية في ماديسون و ويسكونسن و مدن أمريكية أخرى.
سأتطرق أولاً إلى حدثٍ وقع في العشرين من شباط و ذلك عندما أرسل كمال عباس16 رسالة من ساحة التحرير إلى عمال ويسكونسن يقول فيها: نقف إلى جانبكم كما وقفتم إلى جانبنا. و يعد كمال عباس قائد سنوات من الصراع على الحقوق الأساسية للعمال المصريين و قد حفزت رسالته التطلعات التقليدية للحركة العمالية؛ هذه التطلعات التي تدعو إلى التلاحم بين عمال العالم و بين الشعوب بشكل عام.
بغض النظر عن بعض الخلل و الأخطاء في مسيرتهم, كانت الحركات العمالية دوماً في مقدمة الصراعات الشعبية من أجل الحقوق الأساسية و الديمقراطية. في الحقيقة ترقى الحركات العمالية التي تقود القوى في ساحة التحرير و شوارع ماديسون و العديد من مناطق الصراعات الشعبية الحالية مباشرة إلى مطامح ديمقراطية حقيقية؛ أي الوصول إلى أنظمة اجتماعية سياسية حيث الناس كلهم معنيون أحرار و متساوون في إدارة المؤسسات التي يعيشون منها و يعملون فيها.
تتقاطع حالياً المسارات في كل من القاهرة و ماديسون و لكنهما تتجهان إلى منحيين مختلفين. فالهدف الأساسي في القاهرة هو الحصول على الحقوق الأساسية التي منعتها الديكتاتوريات, أمّا في ماديسون فالهدف الدفاع عن حقوق رُبحت سابقاً بعد صراع مرير و تواجه الآن هجوماً شرساً. كلاهما ( القاهرة و ويسكونسن) عالم صغير من التوجهات في مجتمع عالمي و كلاهما يتبعان مسارين مختلفين. بالتأكيد سينجم عن ذلك عواقب كبيرة على أمريكا التي أصبحت قلب العالم الصناعي المتردي بعدما كانت أغنى الدول في التاريخ البشري, و على مصر التي دعاها الرئيس أيزنهاور بالمنطقة الأهم استراتجياً في العالم والمصدر الهائل للقوة الإستراتجية,و الجائزة الاقتصادية الأغلى في العالم في مجال الاستثمار الأجنبي, كما جاء في كلمات وزارة الخارجية خلال أربعينات القرن الماضي. وهي جائزة أرادتها الولايات المتحدة لنفسها و لحلفائها في النظام العالمي الجديد المتكشف المعالم منذ تلك المرحلة. بالرغم من كل التغيرات التي جرت حينئذٍ لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن صناّع السياسة الحاليين مخلصون بشكل رئيسي لحكمة إي إي بيرلي (A.A. Berle )- المستشار المتنفذ للرئيس روزفلت- والتي تقول بأن التحكم بمصادر الطاقة التي لا مثيل لها في الشرق الأوسط سيؤدي إلى هيمنة قوية على العالم. بالمقابل فإن خسارة هذه الهيمنة ستهدد مشروع السيطرة العالمية الذي تم الإفصاح عنه خلال الحرب العالمية الثانية, و الذي استمر في مواجهة كافة التغيرات التي مرّ بها النظام العالمي منذ أربعينيات القرن الماضي.
بعد اندلاع حرب 1939 توقعت واشنطن بأنها ستنتهي باحتلالها لمركز القوة العظمى الوحيدة في العالم. حيث التقى موظفون مهمون في وزارة الخارجية مع خبراء في السياسة الخارجية خلال سنوات الحرب من أجل وضع خططٍ تحدد معالم عالم ما بعد الحرب. وضعوا الخطوط العريضة للمنطقة الكبرى ( Grand Area) التي من المفترض أن تسيطر عليها الولايات المتحدة بما في ذلك القسم الغربي و الشرق الأقصى و الإمبراطورية البريطانية السابقة و معها مصادر الطاقة في الشرق الأوسط. كانت روسيا أنذالك في بداية انهزامها أمام الجيوش النازية بعد معركة ستالينغراد. و قد اتسعت أهداف المنطقة الكبرى لتشمل ضم أكبر مساحة ممكنة من اوراسيا و مركزها الاقتصادي في أوربا الغربية على الأقل, حيث ستقوم الولايات المتحدة و ضمن حدود هذه المنطقة الكبرى بالحفاظ على قوة لا منازع لها و تفوق عسكري و اقتصادي و تأمين أقل حد ممكن لأي ممارسة سيادية , و في الحين نفسه تحتوي الدول التي قد تتدخل في خططها العالمية. وطُبقت هذه الخطط الدقيقة لمرحلة الحرب بكل السرعة الممكنة.
كان هناك إحساس دائم بأن أوربا قد تختار إتباع مسارها الاستقلالي الخاص و لهذا فقد كانت مهمة حلف الناتو جزئياً تقويض أي تهديد من هذا النوع. فحالما انهارت الذريعة الرسمية لحلف الناتو في عام 1989 توّسع الحلف باتجاه الشرق في خرق واضح للتعهدات الشفوية التي أُعطيت لغورباتشوف. بناءً على هذا أصبح الناتو منذ ذلك الحين قوة تدخل تديرها الولايات المتحدة بمجال واسع. و قد عبّر غييب دي هووب شيفر الأمين العام للحلف آنذاك (Jaap de Hoop Scheffer) في مؤتمر للناتو عن هذه الحقيقة حين قال بأن مهمة الناتو هي حماية أنابيب النفط التي تنقل النفط و الغاز إلى الغرب و بشكل أوسع تأمين الطرق البحرية التي تستخدمها الناقلات النفطية و حماية البنى التحتية الأخرى لنظام الطاقة.
كما هو واضح فإن عقائد المنطقة الكبرى تعطي ترخيصاً بالتدخل الأجنبي و وفق ما يراد له أن يكون. و قد عبرت ادراة كلينتون بشكل واضح عن هذه الخلاصة التي منحت الولايات المتحدة حق استخدام القوة العسكرية من أجل تأمين دخول غير محدود إلى الأسواق الرئيسية و إمدادات الطاقة و المصادر الإستراتجية و الحفاظ على قوى عسكرية كبيرة منتشرة مُقدماً في أوربا و آسيا من أجل تشذيب آراء الشعوب بخصوصنا و التحكم بالظروف التي قد تؤثر على معيشتنا و أمننا.
دعمت المبادئ نفسها قرار غزو العراق حين أصبح فشل الولايات المتحدة في فرض إرادتها على العراق أمراً واقعاً ولم تعد الأسباب الحقيقية وراء أي خطاب برّاق للإدارة مخفيّة. و قد أصدر البيت الأبيض في تشرين الثاني 2007 إعلاناً حول الأسباب اللازمة لبقاء القوات الأمريكية في العراق إلى أجل غير محدد و تسليم البلد إلى مستثمرين أمريكيين ( أصحاب امتيازات) ممن تدعمهم واشنطن. حيث أخطر الرئيس بوش الكونغرس بعد شهرين من هذا الإعلان بأنه سيرفض أي قانون قد يحد من التمركز الدائم للقوات الأمريكية المسلّحة في العراق أو من سيطرة الولايات المتحدة على مصادر النفط العراقية. و هذا يعني , وفقاً لوجهة نظر بوش, أن يُطلب من الولايات المتحدة بعد ذلك الحد من بقاء القوات الأمريكية في العراق و الاستسلام في وجه المقاومة العراقية.
حصد الحراك الشعبي في تونس و مصر انتصارات مهمة, لكن منذ بضعة أيام خلت أوردت منظمة كارنيغي انداومنت 19(Carnegie Endowment)بأن التغيير في النخبة الحاكمة و نظام الحكم لا يزال هدفاً بعيداً في دلالة واضحة إلى أن الأسماء قد تتغير و لكن النظام سيستمر. هذا و يناقش تقرير كارنيغي انداومنت العوائق الداخلية أمام الديمقراطية و لكنه يتجاهل العوائق الخارجية و هي كالعادة على القدر نفسه من الأهمية.
تملك الولايات المتحدة و حلفائها الغربيين ثقة بفعل ما يلزم لمنع قيام أي ديمقراطية حقيقية في العالم العربي, و من أجل فهم سبب هذا فمن الضروري النظر إلى استطلاعات أراء العرب التي تقوم بها وكالات الاستطلاع الأمريكية. على الرغم من أنها بالكاد تظهر في التقارير و لكنها تؤخذ في حسبان من يضع الخطط. تُظهر استطلاعات هذه الوكالات بأن العرب, الغالبية الساحقة منهم, يعتبرون إسرائيل و الولايات المتحدة مصدر التهديد الأكبر الذي يواجهونه ( 90% من المصريين و أكثر من ثلاث أرباع المنطقة؛ بالمحصلة تعتبر الغالبية أمريكا مصدر تهديد بينما يعتبر قسم نسبته 10% إيران كمصدر تهديد). إنّ المعارضة للسياسة الأمريكية قوية جداً لدرجة أن الغالبية تؤمن بأن الأمن سيتحسن لو امتلكت إيران أسلحة نووية. ففي مصر وحدها 80% يعتقدون بأن الأمن سيتحسن لو امتلكت إيران سلاحاً نووياً و هناك أرقام أخرى مشابهة في بلدان أخرى. لو كان للرأي العام في الشرق الأوسط قوة ضغط مؤثرة على السياسة لما تمكنت الولايات المتحدة فقط من عدم التحكم بالمنطقة بل كانت ستُطرد منها مع حلفائها, و بالتالي ستنهار دعائم الهيمنة العالمية للولايات المتحدة.
يُعتبر دعم الديمقراطية مجال اختصاص الأيدلوجيين و الدعاة السياسيين, بينما الوضع على أرض الواقع و في العالم الحقيقي هو كره نخبوي للديمقراطية. و هذا أكبر دليل على أن الديمقراطية مدعومة فقط بقدر ما تساهم بتحقيق الأهداف الاجتماعية و الاقتصادية كما أقرّت باستفاضة الجهات الأكثر جديّة.
كشف البغض النخبوي للديمقراطية عن نفسه من خلال ردة الفعل تجاه فضائح وثائق ويكيليكس. فالوثائق التي كانت محط الاهتمام أتت على شكل تعليقات خفيفة و مرحة لم تخفِ دعم العرب لموقف الولايات المتحدة تجاه إيران و الإشارة هنا طبعاً إلى الحكام العرب الديكتاتورين, أمّا موقف الشعب فقد كان غائباً في التسريبات. و هذا المبدأ المركزي للسياسة الأمريكية عبّر عنه مروان مشير48 وهو اختصاصي في شؤون الشرق الأوسط يعمل لصالح منظمة (Carnegie Endowment) و مسؤول سابق رفيع المستوى في الحكومة الأردنية: لا يوجد أي خطأ فكل شيء تحت السيطرة. باختصار إن دعمنا الحكام الديكتاتورين فماذا يهمنا غير هذا؟
ما قاله مشير عقلاني و يستوجب الاحترام, و نذكر على سبيل المثال قضية قريبة و وثيقة الصلة بما نقوله. ففي نقاش مغلق عام1958 عبّر الرئيس أيزنهاور عن قلقه من حملة الكره تجاهنا في العالم العربي و هو حقد من قبل الناس و ليس من قبل الحكومات. و قد بيّن مجلس الأمن القومي وجود اعتقاد في العالم العربي بأن الولايات المتحدة تدعم الديكتاتورين و تمنع الديمقراطية و النمو من أجل التحكم بمقدرات المنطقة. ويتضح, علاوة على ذلك, أن هذا الاعتقاد صحيح بشكل أساسي كما استنتج مجلس الأمن القومي الذي أوصى بما علينا فعله بالتحديد: أي تبني ما جاءت به مقولة مشير. يتوازى هذا مع نتائج الدراسات التي أجراها البنتاغون بعد الحادي عشر من أيلول التي أوضحت حقيقة ما يحدث بالضبط في هذه الأيام.
من الطبيعي أن يرسل المنتصرون التاريخ إلى سلة القمامة و أن يتمسك به المنهزمون بشكل جدي, لذلك قد يكون من المفيد بمكان ذكر بعض الملاحظات المقتضبة بخصوص هذا الموضوع المهم. يمكنني القول بأن هذا اليوم ليس المناسبة الأولى التي تواجه فيها كل من مصر و الولايات المتحدة مشكلة متوازية و تتحركان فيها باتجاهين مختلفين فقد حصل الأمر عينه في بداية القرن التاسع عشر.
جادل المؤرخون الاقتصاديون بأن مصر مرّت سابقاً بوضع مناسب للدخول في نمو اقتصادي متسارع بالتوازي مع الولايات المتحدة. فكلا البلدين امتلكا زراعة غنية بما في ذلك محصول القطن الذي كان وقود الثورة الصناعية. على نقيض مصر كان على الولايات المتحدة أن تطور إنتاج القطن و القوة العاملة فيه عن طريق الاستعباد والإبادة والعبودية التي تبرز تداعياتها الآن في ما يجري لمن نجوا و في عدد السجون التي ازداد منذ أيام ريغان من أجل إيواء الجماعات السكانية الفائضة التي خلّفها أفول هذه الصناعة . هناك فرق واحد أساسي بينهما وهو أن الولايات المتحدة حصلت على استقلالها و بالتالي أصبحت حرة في تجاهل ما أتت به النظرية الاقتصادية التي قدمها آدم سميث(Adam Smith) بشكل أدق مما يُعبر عنه اليوم من قبل الدعاة إلى مجتمعات متطورة.
جادل سميث بأن على المستعمرات المحررة في الولايات المتحدة تصنيع المنتجات الأولية للتصدير و استيراد صناعات بريطانية متفوقة في الوقت عينه, و بالطبع لا يجب أن لا تقدم هذه المستعمرات أبداً على محاولة احتكار السلع الرئيسية بالأخص احتكار سلعة القطن.
و كان من شأن اتخاذ منحى آخر مخالف (محاولة المستعمرات المحررة احتكار السلع ) التسبب بإعاقة. فقد حذر سميث شعوب المستعمرات من أن اتخاذ هذا المنحى المخالف لن يسهل التنامي المتزايد في قيمة الإنتاج السنوي وسيكون عائقاً بدلاً أن يكون ترويجاً لنمو بلدهم باتجاه امتلاك ثروة و عظمة حقيقيتين. و حين استقلت المستعمرات أصبحت حرة في تجاهل النصيحة و اتباع طريقة بريطانيا في التطور المستقل الذي تتحكم به الدولة. و لذلك ارتفعت التعرفة لحماية الصناعة من المستوردات البريطانية و في مقدمتها ارتفعت تعرفة الصناعات النسيجية و لاحقاً الصلب و غيرها وتم تطوير العديد من الأدوات أخرى بغية دفع وتيرة النمو الصناعي. سعت أيضاً الجمهورية الأمريكية المتحدة حينذاك إلى الحصول على احتكار القطن من أجل وضع باقي الأمم كلها تحت أقدامنا, بالتحديد وضع العدو البريطاني تحت أقدامنا, كما أعلن الرؤساء الجاكسونيون عندما كانوا يحتلون تكساس و نصف المكسيك.
بالنسبة لمصر فقد أُعيق منحى مشابه من قبل القوة البريطانية حين أعلن اللورد بالمرستون (Lord Palmerston ) بأنه لا يجب أن تعترض أي أفكار عن العدالة (عدالة تجاه مصر) الطريق أمام مصالح بريطانيا الكبرى و المهمة و ضرورة حماية هيمنتها الاقتصادية و السياسية. و قد عبّرت بريطانيا عن كرهها للبربري الجاهل محمد علي الذي سعى بكل جرأة للحصول على الاستقلال, لذلك استخدمت بريطانيا الأساطيل و القوة المالية من أجل سحق سعي مصر للاستقلال و النمو الاقتصادي.
بعد الحرب العالمية الثانية و حين أصبحت الولايات المتحدة القوة العالمية المهيمنة بدلاً من بريطانيا تبنت واشنطن الموقف ذاته, و أوضحت تماماً بأنالولايات المتحدة لن تقدم أي مساعدة أو عون لمصر ما لم تلتزم الأخيرة بقوانين الطرف الضعيف المتعارف عليها. هذا الطرف الضعيف الذي استمرت الولايات المتحدة بانتهاك حقوقه من خلال فرض تعرفة مرتفعة حتى تعيق إنتاج القطن المصري و تتسبب باستنفاذ عجز الدولار حسب التحليلات المعتادة و وفق معايير السوق. إذاً ليس من الغريب أن حملة الكراهية تجاه الولايات المتحدة و التي أثارت قلق أيزنهاور استندت على الاعتقاد بأن الولايات المتحدة وحلفاؤها يساندون الديكتاتوريين و يمنعون الديمقراطية و التنمية.
يجب أن نضيف و ي دفاع عن آدم سميث أن الأخير أدرك ما سيحدث في حال اتبعت بريطانيا قوانين الاقتصاديات الثابتة التي تدعى الآن ب الليبرالية الجديدة. فهو من حذّر بأنه في حالة توجه المصنعون و التجار و المستثمرون البريطانيون إلى الخارج فأنهم سيربحون و لكن بريطانيا ستعاني. كان لدى سميث أملاً بأن المصنعين و التجار سيتحيزون للوطن, بالتالي و بيد خفية, سيوفرون على بريطانيا ما قد تؤدي إليه العقلانية الاقتصادية الداعية للتوجه إلى الخارج. من الصعب تفويت هذا المقطع ففيه الإشارة إلى العبارة الشهيرة يد خفية في ثروات الأمم (عنوان أحد كتب آدم سميث المثيرة للجدل). ينتهي ديفيد ريكاردو(David Ricardo), مؤسس آخر للاقتصاديات الكلاسيكية, إلى النتائج نفسها آملاً أن يقود التحيز للوطن رجال الأعمال إلى الاقتناع بأرباح منخفضة في بلدهم بدلاً من السعي إلى استغلال أكثر ربحاً لثرواتهم في البلاد الأجنبية و هي ثروات ستشعره بالأسى في حال واجهت التراجع. لكن بغض النظر عن توقعاتهم فإن حدس الاقتصاديين التقليديين كان صائباً و سليماً.
يمكن مقارنة حراك الديمقراطية في العالم العربي أحياناً بما حدث في أوربا الشرقية في 1989 و لكنها ستكون مقارنة على أرضية أقل صلة بين الحدثين. ففي عام 1989 قمع الروس حراك للديمقراطية مدعوم من القوى الغربية بما ينسجم مع العقيدة الأساسية التي تقول بتوائم الديمقراطية مع الأهداف الاقتصادية والإستراتجية الغربية. آنذاك عَدّت القوى الغربية هذا الحراك انجازاً نبيلاً و حظي بالكثير من الشرف مقارنة بما حصلت عليه صراعات أخرى جرت في المرحلة نفسها كالصراعات الشعبية الداعمة لحقوق الإنسان الأساسية لشعوب أمريكا الوسطى حسب كلمات رئيس الأساقفة آل سلفادور الذي اغتيل و هو واحد من مئات آلالاف ضحايا القوة العسكرية المسلحة و المدّربة من قبل واشنطن. لم يكن هناك غورباتشوف في الغرب خلال هذه الأعوام المرعبة و لا يوجد غورباتشوف الآن أيضاً و لكن تبقى القوى الغربية معادية للديمقراطية في العالم العربي لأسباب وجيهة.
تستمر عقائد المنطقة الكبرى بالامتثال للأزمات والمواجهات المعاصرة ووفق مجامع صناع السياسة الغربية و التعليقات السياسية. يشكل الآن التهديد الإيراني الخطر الأكبر على النظام العالمي و بالتالي يجب أن يشغل هذا التهديد الاهتمام المحوري في سياسة الولايات المتحدة الخارجية و أوربا التي تنتهج السياسة الأمريكية بكل تهذيب.
ما هو بالتحديد التهديد الإيراني؟
هناك جواب رسمي على هذا السؤال يقدمه كل من البنتاغون و الاستخبارات الأمريكية (CIA). ففي تقرير عن الأمن العالمي العام الماضي أوضحوا بأن تهديد إيران ليس عسكرياً و استنجوا بأنّ الإنفاق العسكري الإيراني منخفض نسبياً مقارنة بمثيله في بقية المنطقة, و بأن عقيدة إيران العسكرية لا تتعدى كونها دفاعية و مصممة لإعاقة أي احتلال و فرض حل دبلوماسي في حال وجود أعمال عدائية.
حسب اقتباسات الجميع فما تملكه إيران حقاً هو قدرة محدودة لإبقاء مجال الاحتمالات مفتوح أمام ممارسة القوة خارج حدودها, و مع اعتبار الخيار النووي فإن برنامج إيران النووي و قابليته للإبقاء على احتمالات مفتوحة لتطوير أسلحة نووية جزء أساسي في إستراتجيتها الرادعة.
بلا شك هذا النظام الديني القاسي يشكل تهديداً على شعبه بالرغم أنه بالكاد يضاهي ما يفعله حلفاء أمريكا في هذا المجال و لكن هذا التهديد غير حقيقي على صعيد آخر و نذير شؤم في الواقع. هناك عنصر واحد يجب ذكره و هو أنّ القدرة الرادعة لإيران و أي محاولة من قبلها لممارسة سيطرة غير شرعية قد يشكلان عائقاُ أمام حرية عمل الولايات المتحدة في المنطقة. من الواضح بما لا يخفى سبب سعي إيران لامتلاك قدرة رادعة فنظرة واحدة إلى القواعد العسكرية الأمريكية و النفوذ النووي في المنطقة كافٍ لشرح السبب. منذ سبعة أعوام مضت كتب المؤرخ العسكري الإسرائيلي مارتن كريفلد (Martin van Creveld)3 بأن العالم شهد كيف هاجمت الولايات المتحدة العراق من أجل لا شيء كما ظهر لاحقاً. لهذا فإن لم يحاول الإيرانيون صناعة أسلحة نووية فهم مجانين. خاصة و أنهم تحت تهديد مستمر بالتعرض لهجوم يخرق ميثاق الأمم المتحدة. لكن سواء فعلوا هذا أم لا سيبقى السؤال مفتوحاً أمام الاحتمالات, لكن على الأغلب هم يفعلون ذلك.
و الخطر التي تشكله إيران يتجاوز سياستها الرادعة فهي تسعى إلى توسيع نفوذها في البلدان المجاورة كما يؤكد البنتاغون و السي آي ايه, و هو توسع يُضعف استقرار المنطقة وفق المصطلحات التقنية لخطاب السياسة الأمريكية الخارجية. في الحين نفسه يعتبرون غزو الولايات المتحدة و الاحتلال العسكري لجيران إيران تحقيق استقرار و ينظرون إلى جهود إيران لمد نفوذها على هذه المناطق إضعاف لهذا الاستقرار و لهذا اعتبروه توسعاً غير شرعي. مثل هذا الاستخدام المزدوج للمصطلحات شائع, و على الأغلب استخدم محلل السياسية الخارجية البارز جيمس تشاس مصطلح الاستقرار بمعناه التقني عندما وضّح بأنه و من أجل تحقيق الاستقرار في تشيلي فمن الضروري إضعاف استقرار البلد ( من خلال الإطاحة بحكومة الليندي المنتخبة و وضع ديكتاتورية بينوشيه بدلاً منها). هناك مصادر قلق أخرى مثيرة للاهتمام أكثر من قضية توسع إيران لكن يكفي على الأغلب كشف المبادئ الأساسية و وضعها في ثقافة امبريالية كما أكد المخططون أيام روزفلت حين أرسيت عقيدة النظام العالمي المعاصر القائلة بعدم تحمل للولايات المتحدة لأي ممارسة مستقلة للسيادة بما يتعارض مع مخططاتها العالمية.
تتحد كل من الولايات المتحدة و أوربا في معاقبة إيران من أجل التهديد الذي تضعه على الاستقرار و لكن من المفيد أن نتذكر كم هم معزولون في موقفهم. فقد دعمت الدول غير المتحيزة بحماسة حق إيران في تخصيب اليورانيوم و في المنطقة يبدو أن الرأي العربي العام يفضل بشدة أن تمتلك إيران أسلحة نووية. هذا و قد صوتت قوى إقليمية كبرى كتركيا ضد حركة العقوبات الأمريكية الأخيرة في مجلس الأمن بالتوازي مع البرازيل البلد الأكثر إثارة للاحترام في أمريكا الجنوبية. و لكن هذا العصيان سبب لهم توبيخاً لاذعاً ليس الأول من نوعه. فقد كانت تركيا محط للإدانة المريرة في 2003 عندما حققت الحكومة إرادة 95% من الشعب و رفضت المشاركة باجتياح العراق؛ هذا يعني بأن قبضتها الديمقراطية ضعيفة حسب التعريف الغربي للديمقراطية.
تلقت تركيا, بعد إساءتها للتصرف في مجلس الأمن العام الماضي, تحذيراً من فيليب غوردن و هو دبلوماسي رفيع المستوى خاص بالشؤون الأوربية. و من جهته استطرد أوباما تحذير فيليب غوردن قائلاً بأنه يتوجب على تركيا أن تظهر التزامها بالشراكة مع الغرب. و قد تساءل أحد الباحثين في العلاقات الخارجية للمجلس عن كيفية إبقاء الأتراك على المسار؟ يتبعون الأوامر كديمقراطيين جيدين.
ظهر عتب على رئيس البرازيل لولا في عنوان بجريدة النويورك تايمز حيث أظهرت الجريدة جهود لولا المشتركة مع جهود تركيا في سبيل تقديم حل لقضية تخصيب اليورانيوم خارج إطار قوة الولايات المتحدة على أنها وصمة عار في إرث القائد البرازيلي. باختصار: افعلوا ما نقول و إلاّ.
يتحدث العدد الحالي لمجلة فورن أفيرز(Foreign Affairs):
يتضح عرضياً و بشكل لافت احتمالية أن أوباما وافق مقدماً على الاتفاق الإيراني التركي- البرازيلي بناءً على اعتقاد بأنه سيفشل. بالتالي فهو قد أشهر في وجه إيران سلاحاً أيدلوجياً و لكن عندما نجح الاتفاق تحولت هذه الموافقة إلى توبيخ. حاولت واشنطن التملص من موافقتها عبر قرار من مجلس الأمن و لكنه أتى قراراً ضعيفاً لدرجة أن الصين وقعت عليه فوراً و هي الآن معاقبة لأنها كانت على مستوى ما جاء فيه حرفياً و ليس على مستوى الأهداف الأحادية لواشنطن.
في الحين الذي تحملت فيه الولايات المتحدة العصيان التركي بخيبة أمل لم يسهل عليها تجاهل موقف الصين. و حذرت الصحافة من أن المستثمرين و التجار الصينيين يملؤون الآن فراغاً في إيران على شكل صفقات عمل من بلدان أخرى, بالتحديد, من بلدان أوربية و قد نجحوا خاصة أنهم بدؤوا يوسعون دورهم المسيطر على صناعات الطاقة الإيرانية, و يظهر أن واشنطن رضخت لهذا الوضع بمسحة يأس.
و قد حذرت وزارة الخارجية الأمريكية الصين بأنها في حال أرادت أن يقبلها المجتمع الدولي, و هذا مصطلح تقني يشير إلى الولايات المتحدة و كل من يتفق معها, فعليها ألا تلتف و تتهرب من المسؤوليات الدولية( الواضحة)؛ و نعني بذلك أن تمتثل للأوامر الأمريكية. لكن من غير المرجح أن تتأثر الصين بهذا التحذير.
يتعاظم القلق أيضاً من التهديد العسكري المتصاعد للصين. فقد حذر تقرير حديث للبنتاغون من ارتفاع إنفاق الميزانية العسكرية للصين إلى خُمس ما أنفقه البنتاغون على الحروب في العراق و أفغانستان. و هذا بكل تأكيد بالكاد يرقى إلى مكافئ حقيقي مقارنة بنفقات الميزانية الأمريكية العسكرية. و تحذر جريدة النويورك تايمز من أن أي توسع في القوة العسكرية للصين قد يؤدي إلى حرمان قدرة السفن الحربية الأمريكية من العمل في المياه الدولية قبالة شواطئ الصين .
إذاً حرمان الولايات المتحدة من العمل قبالة شواطئ الصين مما يعني أن تقلّص من قوتها العسكرية و تحرم بالمقابل السفن الحربية الصينية من العمل قبالة شواطئ الكاريبي. و يتضح أكثر قصور قدرة الصين في فهم قوانين اللياقة الدولية من خلال اعتراضها على خطط بناء حاملات طائرات جورج واشنطن العاملة بالطاقة النووية والتي تنضم إلى التدريبات البحرية على بعد عدة أميال من الشاطئ الصيني على أساس أنها قريبة و قادرة على ضرب بكين.
على نحو مغاير يتفهم الغرب أسباب كل هذه العمليات التي تجريها الولايات المتحدة و التي يراها ضرورية من أجل حماية استقرار و أمن أمريكا. حيث يعبّر المحافظون الليبراليون الجدد عن قلقهم بأن الصين قد أرسلت عشرة سفن حربية عبر المياه الدولية قبالة الجزيرة اليابانية أوكينوا. بالتأكيد هذا عمل استفزازي من قبل الصين, و هو استفزاز لا يمكن مقارنته أبداً بذلك الاستفزاز الذي تُغفل واشنطن ذكره حين حولت الجزيرة إلى قاعدة عسكرية لها متحدية بذلك الاحتجاجات الشعبية الكبيرة ضد وجودها على الجزيرة. هذا بالتأكيد ليس استفزازاً أبداً بناءً على أساس أننا نملك العالم.
لنضع جانباً العقيدة الامبريالية المتأصلة فهناك أسباب وجيهة تدعو جيران الصين إلى القلق من قوتها العسكرية و التجارية المتصاعدة. على الرغم من أن الرأي العام العربي يدعم برنامج الأسلحة النووية الإيرانية فهذا لا يعني أننا يجب أن ندعمه. هذا و تزخر أدبيات السياسة الأمريكية الخارجية بالطروحات لمواجهة هذا الخطر. من أحد هذه الطروحات طرحٌ غير متداول إلا فيما ندر و يقوم على أساس الدعوة إلى قيام منطقة خالية من الأسلحة النووية في المنطقة.
تكرر طرح هذا الحل خلال مؤتمر منع انتشار الأسلحة النووية ( NPT) في مركز الأمم المتحدة أيار الماضي. حيث دعت مصر بصفتها رئيسة مئة و ثمانية عشرة دولة في حركة دول عدم الانحياز إلى مفاوضات لقيام منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط, تماماً كما جاء في الاتفاق مع الدول الغربية عقب مؤتمر مراجعة اتفاقية عدم انتشار الأسلحة عام 1995. و كان الدعم العالمي لهذا الحل كبيراً جداً إلى درجة أن أوباما وافق عليه رسمياً على أساس أنه فكرة جيدة. و لكن واشنطن أبلغت المؤتمر بضرورة تأجيل الموضوع حالياً. هذا و قد أوضحت الولايات المتحدة ضرورة استثناء إسرائيل. فما من داع لوضع البرنامج النووي الإسرائيلي تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) أو نشر أي معلومات بخصوص المنشئات و النشاطات النووية الإسرائيلية. و لا يسعنا القول إلّا أن هذه طريقة بعيدة كل البعد عن طريقة التعامل مع الخطر النووي الإيراني.
بما أن عقيدة المنطقة الكبرى مستمرة فإن القدرة على تطبيق هذا الحل تراجعت. وصلت قوة الولايات المتحدة إلى أقصاها بعد الحرب العالمية الثانية و ذلك عندما امتلكت نصف ثروة العالم تماماً. و لكن هذا تراجع في الوقت التي تعافت فيه اقتصاديات صناعية أخرى من دمار الحرب ومضت مرحلة ما بعد الاستعمار في طريق التعافي المؤلم. مع بداية عام 1970 انخفضت حصة الولايات المتحدة من الثروة العالمية إلى حوالي 25% و أصبح العالم تحت سيطرة ثلاثية القطب تتضمن أمريكا الشمالية و أوربا و أسيا الشرقية التي كانت اليابان مركزها حينئذٍ.
حدث أيضاً تغيير كبير في الاقتصاد الأمريكي منذ سبعينيات القرن الماضي و هذا التغيير كان باتجاه مزيد من الدعم المالي و تصدير الإنتاج. ليس لدينا الوقت الكافي للخوض في التفاصيل و لكن هناك مجموعة من العوامل تلاقت و أنتجت حلقة مفرغة من التركيز الراديكالي للثروة و بالأخص بأيدي القسم الأعلى ل 1% من السكان من مدراء تنفيذيين و من على شاكلتهم. و أدى هذا التركيز الاقتصادي إلى تركيز سياسي, أي تركيز السياسة الحكومية, من أجل مزيد من التركيز الاقتصادي و ذلك عن طريق انتهاج سياسات خاصة بالخزينة و قوانين محابية تدعم سيطرة الشركات و تحرير القيود و غيرها الكثير. و ارتفعت خلال هذا الوقت تكلفة الحملات الانتخابية بشكل كبير مما دفع الأحزاب إلى الجيوب حيث يتركز رأس المال و المقدرات المالية المتزايدة. اندفع الجمهوريون أولاً بقوة و لحقهم الديمقراطيون ممن باتوا يعرفون الآن بالجمهوريين المعتدلين.
أصبحت الانتخابات تمثيلية تديرها صناعة العلاقات العامة. فبعد فوزه في انتخابات 2008 ربح أوباما جائزة من هذه الصناعة عن فئة أفضل تسويق لحملة انتخابية ذلك العام. و كان المنتجون سعداء جداً و أوضحوا في صحف الأعمال بأنهم يسوقون المرشحين مثل أي سلعة أخرى منذ عهد ريغان و كان تسويق عام 2008 أعظم انجازاتهم و مما سيغير بلا شك من أسلوب عمل مجلس الشركة. يتوقع المراقبون أن تكلف انتخابات 2012 حوالي 2 بليون دولار و معظمه تموله الشركات و هنا لا نتعجب من اختيار أوباما لقادة رجال الأعمال لشغل مناصب رفيعة. هذا كله و الشعب غاضب و يائس و لكن ما دام مبدأ المشير يحكم فهذا لن يكون بذي أهمية؛ فالثروة و القوة تركزتا بشدة و تراجع مدخول الغالبية الكبرى من السكان التي بالكاد تدبر أمورها مع ساعات عمل متزايدة و ديون و تضخم و دمار ناجم عن الكوارث المالية التي تحل منذ تم تفكيك الجهاز الناظم للاقتصاد في ثمانيات القرن الماضي.
كل ما نقوله لا يعتبر مشكلة بالنسبة للأغنياء جداً ممن ينتفعون من سياسة التأمين الحكومية التي تدعى سياسة أكبر من أن تفشل. يمكن للبنوك و شركات الاستثمار القيام بتعاملات خطيرة و يحققون بذلك عوائد ثمينة و لكن عندما ينهار النظام حكماً سيطلبون من الحكومة الراعية المساعدة من مال دافعي الضرائب بينما يمسكون بنسخهم من كتب (Hayek) و( Milton friedman). لقد كان هذا المسار الطبيعي منذ عهد ريغان و كل أزمة أتت كانت أخطر من سابقتها و أقصد هنا أخطر على الناس.
يوجد الآن, بالنسبة للكثير من السكان,عطالة حقيقية عن العمل تكاد تصل إلى مستويات الكساد. و في الحين عينه أصبح أحد المهندسين الرئيسين للأزمة الحالية أغنى من قبل. فقد أعلن غولدمان ساكس(Goldman Sachs)26 مؤخراً عن تعويض قيمته 17.5 مليار دولار للعام الماضي و تلقى المدير التنفيذي في الشركة لويد بلانكفين علاوة قدرها 12.6 مليون دولار بينما راتبه الأساسي أكثر من ذلك بثلاثة أضعاف.
ليس من المجدي التركيز على حقائق كهذه فالدعاية المغرضة سعت على مدى شهور قليلة خلت إلى لوم آخرين في قطاعات العمال العام على أساس أن رواتبهم كبيرة و تقاعدهم باذخ و هكذا دواليك. كل هذا مجرد أوهام تماماً مثل وهم الصورة الريغانية النمطية التي أظهرت الأم السوداء تركب سيارة ليموزين و هي في طريقها لقبض شيكات الرعاية بالإضافة إلى نماذج أخرى لا داعٍ لذكرها الآن. إذا يجب علينا جميعاً شد أحزمتنا ربما ليس جميعنا بل غالبيتنا كما هي حقيقة الأمر.
يشكل المعلمون بالتحديد هدفاً جيداً للدعاية المغرضة لأنهم جزء من الجهد المدروس الساعي إلى تدمير نظام التعليم العام من دور الحضانة إلى الجامعات و ذلك عن طريق خصخصة قطاع التعليم. مجدداً هذا جيد للأغنياء و لكنه كارثي على الناس و على الصحة المديدة للاقتصاد أيضاً. و يبقى هذا مجرد أمر واحد من الأمور الجانبية غير المهمة لصناع القرار ما دام مبدأ السوق هو ما يسود حقاً.
يشكل المهاجرون أيضاً هدفاً آخراً دائم و رائع للدعاية المغرضة. تتضح حقيقة هذا عبر تاريخ الولايات المتحدة و بشكل خاص في أوقات الأزمات الاقتصادية حين يتعاظم شعور الغضب من أن البلد يؤخذ منا ( نحن السكان البيض) فالسكان البيض سيصبحون أقلية قريباً. يمكن أن يتفهم المرء الغضب أو الأفراد الغاضبين و لكن قساوة هذه السياسة مفجعة فمن هم يا ترى المهاجرون المستهدفون؟
يتكون السواد الأعظم للمهاجرين في ماسيتشوتس الشرقية (Eastern Massachusetts) حيث أقطن من المايان الهاربين من المجازر في الأراضي الغواتمالية, و هي مجازر قام بها قتلة محببين لريغان و مهاجرون آخرون هم ضحايا مكسيكيون لاتفاقية( NAFTA)27. حيث استطاعت هذه الاتفاقية الخاصة التي وقعها كلينتون إيذاء العمال في كل من البلدان الثلاث المشاركة. و لقد تم التخلي عنها أثناء اعتراض عام للكونغرس في عام 1994. أطلق كلينتون بعدها حملة عسكرة للحدود الأمريكية المكسيكية التي كانت فيما مضى مفتوحة تماماً. كان من المعتقد بأن المزارعين المكسيكيين لا يستطيعون منافسة الصناعات الأمريكية و بأن الشركات المكسيكية لن تنجو من المنافسة مع الشركات الأمريكية المتعددة الجنسية, هذه الشركات التي يجب أن تُمنح معاملة وطنية من قبل المكسيك وفق شروط الاتفاقيات المضللة للتجارة الحرة. و كان امتياز تلقي معاملة وطنية يُمنح فقط إلى شخصيات الشركات و ليس إلى أناس من لحم و دم. لا يفاجئنا أن تقود هذه الإجراءات إلى طوفان من اللاجئين اليائسين و إلى تصاعد هيستريا معاداة المهاجرين من قبل ضحايا سياسات الدولة/الشركات في أمريكا.
يبدو أن هذا ما يحدث في أوربا أيضاً حيث التفرقة العرقية أكثر عنفاً منها في الولايات المتحدة. لا يملك المرء إلا أن يراقب بتعجب كيف تشتكي ايطاليا من تدفق اللاجئين من ليبيا و هو يشبه مشهد المجزرة الأولى للحكومة الايطالية الفاشية بعد الحرب العالمية الأولى في الشرق المتحرر الآن. أو عندما غضت فرنسا,الحامي الأساسي للديكتاتوريات الوحشية في مستعمراتها السابقة حتى اليوم, عن أعمالها الوحشية البشعة في أفريقيا و في الوقت نفسه يحذر ساركوزي بشراسة من طوفان المهاجرين بينما تعترض ماريان لي بن (Marine Le Pen ) بأن ساركوزي لا يفعل شيئاً حيال الموضوع. و لا أحتاج لذكر بلجيكا التي قد تربح جائزة على اللاعدالة البربرية الخاصة بالأوربيين كما دعاها آدم سميث.
إن ظهور الأحزاب الفاشية الجديدة في معظم أوربا سيكون ظاهرة مخيفة حتى لو لم نستعرض ما حدث على القارة في الماضي القريب. فقط تخيل ردة الفعل لو أن اليهود طُردوا من فرنسا إلى البؤس و القمع و راقب حينها غياب أية ردة فعل عندما يحدث هذا في روما لأناس هم أيضاً ضحايا المحرقة و ضحايا أكثر الأوربيين تجرداً من الإنسانية. في هنغاريا حصل حزب جوبيك (Jobbik ) الحزب الفاشي الجديد على 17% من الأصوات في الانتخابات العامة. ربما هذا لا يثير العجب في حين ثلاث أرباع السكان تهاجر و أوضاعهم أسوأ مما كانت عليه أثناء الحكم الشيوعي. قد نشعر بالراحة لفوز اليميني المتطرف غورغ هيدر(Jörg Haider) بنسبة 10 % فقط من الأصوات في2008 في النمسا و لم يكن هذا ليحصل لو لم يطوقه حزب الحرية الجديد. أما لو بقي في أقصى اليمين المتطرف لربح أكثر من 17% من الأصوات.
ما يثير القشعريرة أن نتذكر أنه في عام 1928 ربح النازيون الانتخابات في ألمانيا بنسبة أصوات أقل ب 3%. أما في بريطانيا فيعد كل من الحزب البريطاني الوطني و عصبة الدفاع البريطانية في الجناح اليميني المتعصب عرقياً من أكبر القوى و ما يحدث في هولندا تعرفونه جيداً. في ألمانيا كان اتهام ثيلو سارازين (Thilo Sarrazin) للمهاجرين بأنهم يدمرون ألمانيا من أكثر الكتب مبيعاً على الرغم من أن المستشارة أنجيلا ميريكل (Angela Merkel) أدانت ما جاء في الكتاب, لكنها في الوقت عينه أعلنت بأن سياسة التعددية الثقافية قد فشلت فشلاً ذريعاً, فقد فشل الأتراك المستوردون للقيام بالأعمال القذرة في التحول إلى أصحاب بشرة بيضاء و عيون زرقاء و بذلك فشلوا في التحول إلى آريين حقيقيين.
وسيتذكر من يملك حس السخرية بنجامين فرانكلين (Benjamin Franklin) أحد الشخصيات القيادية في فترة التنوير. لقد حذر فرانكلين بأن على المستعمرات المحررة حديثاً الحذر من السماح للألمانيين بالهجرة لأنهم من ذوي البشرة القذرة(Swarthy) و السويديين أيضاً على حد سواء. كانت الخرافات السخيفة عن نقاء الأنغلوساكسونين منتشرة في أمريكا خلال القرن العشرين و من بينها تلك التي تناولت الرؤساء و شخصيات قيادية أخرى. أصبحت التفرقة العرقية في الثقافة الأدبية فحش واضح و نحن بغنى عن القول أن الوضع أسوأ على أرض الواقع. قد تكون قدرتنا على التخلص من شلل الأطفال أكبر من قدرتنا على التخلص من هذا الوباء المرعب و الذي يتكاثر شيئاً فشيئاً في أوقات المحن الاقتصادية.
بهذا أكون بالكاد اقتربت من قشرة هذه القضايا الحرجة و لكن لا أريد أن أختم دون ذكر قضية أخرى تلقى الرفض في أنظمة السوق و هي قضية مصير و مستقبل الأنواع. يمكن علاج الخطر الدائم في النظام المالي بواسطة دافعي الضرائب و لكن لن يقدر أحد على إنقاذ البيئة إن دُمرت و أن يحصل دمار البيئة على يد المؤسسات أقرب إلى الحقيقة. يستوعب قادة رجال الأعمال ممن يقومون بحملة دعائية لإقناع الناس بأن الاحتباس الحراري الذي يسببه البشر هو خديعة ليبرالية حجم هذا الخطر الكبير. و لكن من شأن نشر هذه المعرفة تقليص الأرباح القصيرة الأمد و حصة السوق و إن لم يستغلوها هم أحدٌ آخر سيفعل. قد يتحول هذا إلى حلقة مفرغة مميتة و لكي تعرفوا إلى أي مدى هذا الوضع خطير فقط ألقوا نظرة إلى الكونغرس الجديد في الولايات المتحدة الذي دخل العمل بقوة أموال الأعمال و الدعاية و غالبيتهم ممن ينكرون قضية المناخ. و ها هم قد بدؤوا باقتطاع التمويل الداعم لإجراءات من شأنها تخفيف الكارثة البيئية.
و لكن الوضع أسوء بكثير فبعضهم من المؤمنين المتدينين. على سبيل المثال أوضح رئيس اللجنة الفرعية لشؤون البيئة أن الاحترار الكوني ليس مشكلة لأن الله وعد نوح بأن لا يتكرر الطوفان مرة ثانية. لو حدث هذا في بلد صغير و بعيد لضحكنا, و لكننا لا نضحك عندما يحدث في أغنى و أقوى البلدان في العالم. و قبل أن نضحك يجب علينا أن ألا ننسى بأن الأزمة الاقتصادية الحالية تعود بمقدار صغير إلى الإيمان المتعصب بهذه العقائد على اعتبار أنها فرضيات السوق الأكثر فاعلية, و هذا ما أشار إليه الحاصل على جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز(Joseph Stiglitz) منذ خمسة عشر عام ب الدين التي يؤمن به السوق بشدة. هذا الدين الذي منع كل من البنك المركزي والاقتصاديين من ملاحظ الفقاعة الإسكانية التي تقدر ب 8 تريليون دولار و التي لا تستند أبداً على أساسيات اقتصادية و أدت في النهاية إلى تدمير الاقتصاد عندما انفجرت. كل هذا و الكثير أيضاً يمكن أن يستمر ما دامت عقيدة مشير مستمرة و ما دامت غالبية السكان سلبية و لا مبالية يلهيها الاستهلاك أو الحقد على الضعفاء, عندئذٍ فقط يستطيع الأقوياء أن يفعلوا ما شاءوا و من بقي سيُترك للتفكير بالعاقبة.
 |
حسون |


