من لمصر برجل رشيد وليس مرشد؟
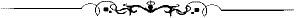
 | |
لينكولن | |
بقلم: مسعد غنيم
....................
الإشكالية الرئيسية التي تواجه مصر الآن على المستوى الفلسفي هي كيفية التوفيق بين ما يدعى "قانون الأخلاق الطبيعية" و "شرعية السلطة المنتخبة ديموقراطيا". حيث لايفتأ المنتمون لتيار الإسلام السياسي الذي تمكن من السلطة في مصر يرددون مقولة شرعية السلطة المنتخبة عبر صناديق الإنتخاب، وذلك في مواجهة مقاومة المعارضة المبعثرة بتكوينها وشباب الثورة الغاضب بطبيعته. تلك المقاومة وذاك الغضب ناتجان مما يراه هؤلاء وأولئك سوء نتائج الحكم وعدم استكمال أهداف الثورة، وأهم من ذلك، قناعتهم بعدم اتساق وعود الرئيس المنتخب مع أفعاله، بل ويتهمونه بممارسة الكذب الصريح، وتجاهل مطالب الثورة من أجل التمكين من الحكم وبسط السيطرة على كل مؤسسات الدولة لصالح جماعة الإخوان المسلمين. أي بنظرهم، الممارسات الغير أخلاقية للحاكم في ظل التلحف بـ "شرعية السلطة المنتخبة".
لا شك أن هناك قطاع كبير من المصريين، وليست فقط المعارضة السياسية وشباب الثورة، يرون أن هناك إنفصال أخلاقي بين مواقف تيار الإسلام السياسي قبل الإنتخابات وبعدها. حيث مارست جماعة الإخوان المسلمين العنف الشديد أثناء الثورة بعدما لحقوا بقطارها، ثم بعد الثورة والتمكن من الحكم ترفض المظاهرات التي تختلط بالعنف لسبب أو لآخر، بل وتحاول تقييدها بقوانين في إطار دستور صنعوه لمصلحتهم في غيبة توافق كانوا قد إدعوه قبل الإنتخابات، أو حتى بفتاوي دينية. كما يبدو هذا الإنفصال الأخلاقي واضحا في رفض التيار السلفي لفكرة الخروج على الحاكم قبل الثورة بل وأثنائها، ثم القبول بنتائج تلك الثورة بل والمشاركة في السلطة التي ورثوها مرحبين مهللين بعد خلع مبارك نتيجة الخروج عليه!.
تلك المفارقة بين أخلاق الحكم وشرعية سلطته، هل هي أمر جديد على المجتمع الإنساني أم أنها قديمة قدم التاريخ؟ وإذا كانت قديمة، فلابد أن البشرية قد تمكنت من حلها بشكل أو بآخر وذلك على الأقل في الدول التي تتمتع بالتقدم والرخاء وما أكثرها بعيدا عن عالمنا العربي المنكوب بذاته أو بفعل غيره، أو بكليهما. فلماذا لا نقرأ التاريخ ونتوقف عن إعادة إختراع العجلة؟!
نشرت مجلة النيوزويك الأمريكية في 14 فبراير 2013 ملخصا لكتاب "مطلوب لينكولن لزماننا، بعنوان فرعي: النفعية الأخلاقية المأساوية للينكولن". كتب الملخص د. ستيفن ب. سميث أستاذ العلوم السياسية بجامعة ييل الأمريكية. وما دفعني للمداخلة للتنويه على الكتاب في "الفيس بوك" قبل كتابة هذا المقال هو أن التحليل التاريخي للثورة الأمريكية ودور إبراهام لينكولن والآباء المؤسسين للديموقراطية الأمريكية كان قد لمس نفس الأسباب الجذرية لما نعيشه فيما بعد الثورة المصرية في يناير 2011، من إكتئاب واقتتال لفظي ومادي، نشهدهما ما بين جماعة الإخوان المسلمين و أطياف معارضة فشلت فيما نجح فيه الإخوان، وبينهما شباب الثورة الحائر الغاضب. هناك تطابق في الأسباب الجذرية التي تشكل المرحلة الإنتقالية لما بعد الثورة، هنا وهناك. ولكن ليس هناك أدنى تشابه في أسلوب معالجة هذه المرحلة التقليدية في عمر أي ثورة بين الحالة المصرية الفاشلة حتى الآن، والحالة الأمريكية الناجحة مع لينكولن. لأننا في الغالب لا نقرأ التاريخ ولا نعتبر به بما يكفي.
عادة ما يطرح البعض، وبحق، إشكالية إختلاف الظرف التاريخي والواقع الجيوسياسي كمانع أو كعائق لتبني حلول الأمم الأخرى، والتي قد تفسر التوجه نحو إعادة إختراع العجلة، أو على الأقل الإجتهاد في إيجاد الحلول المحلية. يقولون مثلا بأهمية أثر عامل الهيمنة الأمريكية المعاصرة كقوة تأثير مباشرة سلبا على الحالة المصرية، وهو عامل غائب تاريخيا في الحالة الأمريكية المنظورة بالكتاب المشار إليه، مما يخصم من قيمة المشابهة أو المقارنة. من هنا يمكن البدء في مناقشة هذه الإشكالية: كيف يمكن المقارنة مع التجربة الأمريكية في الديموقراطية بعد أكثر من 150 سنة، مع اختلاف الظرف التاريخي والواقع الجيوسياسي؟
أكثر ما أراه ممكنا للاستفادة منه هو منهج التحليل التاريخي الذي انتهجه مؤلف الكتاب جون بيرت، لأنه وببساطة، إذا كان المنهج علميا بقدر كاف وبالتالي صحيحا بما يكفي، فإن تطبيقه على الحالة المصرية، حتى بظروفها المختلفة عن الحالة الأمريكية، سيأتي بنتائج مفيدة في جميع الأحوال، على الأقل بشكل أفضل من التخبط في التجربة والخطأ بينما ينهار اقتصاد مصر في ظل حكم فشل حتى الآن – بمعايير المؤسسات الدولية – في تحقيق أي نجاح إقتصادي، بله سياسي، اللهم إلا في مزيد من الاستحواذ على السلطة. ولعله قد آن أن نبدأ في قراءة رشيدة في التجربة الأمريكية من خلال ملخص كتاب جون بيرت عن دور حكمة لينكولن في الاستقرار بعد الثورة الأمريكية وتحقيق ديموقراطية ناجحة بقدر عملي واضح، من خلال التوفيق الذكي بين "قانون الأخلاق الطبيعية" و "شرعية السلطة المنتخبة ديموقراطيا".
الصدق
ما هي مواصفات الرجل الرشيد الذي نأمل أن تلده مصر ليقيمها من عثرتها؟ يبدأ مقدم الكتاب ستيفن سميث بتقديم لينكولن بأهم صفة فيه وهي صفة "لينكولن الصادق"! وهذا تقديم كاف لأن يلقي بظل كئيب على الحالة المصرية حيث أن صفة الصدق هي أبعد ما تكون عن التصور العام لمعظم المصريين عن مرسي ممثل الإخوان في الرئاسة، على الأقل من وجهة نظر المعارضة وشباب الثورة، والأمثلة متعددة ومسجلة صوتا وصورة. هذا لأننا ببساطة نرى منهم الحنث بالوعد (مثلا:عدم الترشح للرئاسة، وعدم السعي لأغلبية برلمانية) والقول بما يخالف الواقع (مثلا: إدعاء مرسي باعتراف متهمين بذنوبهم ثم يطلق القضاء سراحهم في اليوم التالي).
ربما ينتهج الإخوان ذلك النهج لأن لهم تفسيراتهم الدينية للكذب من باب "التقية" أو "الحرب خدعة" وما شابه، تفسيرات للنصوص الدينية يبدو أنها تتسق ومصالحهم وتخص الجماعة فقط، ربما باعتبارهم – من وجهة نظرهم - حماة الإسلام وفي حالة "جهاد" ضد الكفار، ربما!. و بالقطع هناك المثل الإسلامي الأعظم لصفة الصدق والأمانة وهو "محمد الصادق الأمين" قبل أن يصبح رسولا نبيا، ولكن الإدعاء بأن السلوك "السياسي" لجماعة الإخوان المسلمين الحاكمة يتسق مع أخلاق الإسلام فأمر يحتاج لإثبات من أجل إقناع كثير من المصريين الذين يرون غير ذلك.
خلاصة هذه النقطة هي أن شرط "صدق" الحاكم في الحالة المصرية ليس أمرا مجمع عليه بشكل كاف. من هنا يمكننا أن نسنتنج أول نتيجة للمقارنة بالحالة الأمريكية وهي استحالة نجاح الإخوان المسلمين في بناء مصر الديموقراطية في غياب شرط صدق الحاكم، أو الجماعة الحاكمة وذلك في مقابل الآباء المؤسسين في الحالة الأمريكية مع الفارق النوعي طبعا بين جماعة ذات قناعات دينية ومغلقة، ومجموعة مدنية مفتوحة نجحت في إقامة واحدة من أنجح الديموقراطيات في العصر الحديث. هذا بغض النظر عن سياساتها الخارجية العدوانية تجاه العالم وشرقنا العربي على الأخص، ودعمها غير المشروط للمشروع الصهيوني العنصري واللاأخلاقي بالطبع إلا في نظر اليهود المتعصبين الذين يرون في اغتصاب فلسطين تنفيذا لأوامر إلهية طبقا لقناعاتهم الدينية!
الصندوق
كما أشرنا من قبل، لا ينفك الإخوان المسلمون وتيار الإسلام السياسي بصفة عامة عن ترديد مقولة حتمية القبول بنتائج صندوق الانتخاب وما ينتج عنها من شرعية أغلبية تستحق الحكم على إطلاقه، هذا بغض النظر عن الشروط والوعود التي قطعوها على أنفسهم أمام الشعب المصري والتي تشكل الإطار الأخلاقي للإحتكام للصندوق (مثلا: القول بالتوافق حول كتابة الدستور ثم الاستئثار به). فماذا يقول لنا التاريخ عن هذه الإشكالية؟
تقول لنا التجربة الأمريكية في الكتاب الذي بين أيدينا أن الخلاف الجوهري بين لينكولن و دوجلاس (أحد الآباء المؤسسين) أن لينكولن كان يعتقد في "الحق الطبيعي"، بمعنى أن الإلتزام المسبق بالقوانين الأخلاقية هو فقط الذي يصنع مجتمعا حرا، هذا بينما يعتقد دوجلاس في "شرعية الأغلبية"، بمعنى أن ما تريده أغلبية ولاية فيدرالية ما يجعل مما تريده "حقا" مكتسبا!، أي مشروعا. وحتى نعلم مدى قدم هذه الإشكالية الفلسفية بين قوانين الأخلاق وشرعية الحكم يكفي أن نعلم أنها إشكالية قديمة منذ قامت بين سقراط و ثيراسيماخوس في كتاب "جمهورية إفلاطون" قبل قرنين ونيف من الزمان!.
إذن فلسنا في مصر أول من يواجه هذه الإشكالية، وأن لها حلولا تاريخية معروفة، فقط نقرأ التاريخ! فماذا يقول؟ استشهد سنيفن سميث كاتب ملخص كتابنا هذا بالكاتب هاري ف. جافا مؤلف كتاب "أزمة في بيت منقسم" 1959 الذي قرر "أن أي انحراف عن العقيدة المتسامية للقانون الأخلاقي الصرف هو بمثابة إنزلاق إلى النسبية والتاريخانية والفناء في نهاية المطاف." (التاريخانية نظرية تقول بوجود خطة للتاريخ - أي حتمية الأحداث ونفي قيمة إرادة وفعل الإنسان - سواء أكانت خطة إيمانية أم إلحادية - د.يمنى الخولي في ترجمة كتاب أسطورة الإطار للفيلسوف كارل بوبر).
تصور عزيزي القارئ لو أن جهة ما أرادت التخطيط لانزلاق مصر نحو الفناء بعد كل هذا التاريخ المعلوم لتلك الإشكالية الفلسفية، فهل ستجد خيرا من العمل على إنحراف مصر عن قوانين الأخلاق، خاصة وأننا لا نقرأ التاريخ كما قال الصهيوني بن جوريون يوما ما؟! ومن ثم عزيزي القارئ، هل ترى قدرا مطمئنا من الإلتزام بقوانين الأخلاق - كما نعرفها في مصر من أخلاقيات مسيحية وإسلامية ومن قبلها فرعونية، وكما أكدها سقراط ولينكولن وغيرهما في هذالكتاب- فيما نراه من سلوك سياسي لتيار الإسلام السياسي؟
إذن فخلاصة ما نراه في الحالة لمصرية من هذه المتناقضة – قوانين الأخلاق مقابل مشروعية سلطة الأغلبية المتتخبة - تقول بأننا شرعنا بالكاد في إعادة إختراع ما إنتهت منه البشرية منذ أكثر من 2000 سنة، أي سيادة قانون الأخلاق الطبيعي كما صيغ عبر السنين منذ إفلاطون، مرورا بـ سيشرو، توماس الأكويني، جون لوك، إيمانويل كانت و راؤول. الإشكالية الأكبر هنا هي أننا لا نعلم متى سنتمكن من حل تلك الإشكالية القديمة في العالم والجديدة علينا، هذا إذا فعلنا!
الموائمة
كانت المعضلة التي صنعت تاريخ لينكولن هي الخلاف على العبودية ما بين الشماليين والجنوبيين في أمريكا منتصف القرن التاسع عشر 1854. كان لينكولن مستعدا للتفاوض مع الجنوبيين بشأن العبودية كمسألة مؤسساتية، أي مؤسسة العبودية كمؤسسة إقتصادية في الأساس، ولكنه أبدا لم يكن مستعدا للتفاوض بشأنها كمبدأ إنساني، حيث كان يعتبرها شرا وعارا يستلزم الندم عليه، وكان يعمل على أن تصير العبودية إلى الإنقراض الذاتي.. هذا بينما كان دوجلاس يدعو للتفاوض بالإستناد لمبدأ مشروعية إختيار الجنوبيين للعبودية طبقا لرأي الأغلبية بالانتخاب الديموقراطي في ولايات الجنوب، وحيث سيادتهم الشرعية على أرض الجنوب، ومن ثم يفتح الباب للحوار المفتوح معهم على أرضية مشتركة معقولة تسمح بالتوائم. أي باختصار، كانت الإشكالية هي الموائمة بين القيم الأخلاقية المتمثلة في رفض لينكولن لمبدأ العبودية، ومرجعية دوجلاس في مشروعية حكم الأغلبية المنتخبة ديموقراطيا في إطار سيادتها القانونية.
من هنا كان موقف لينكولن ضد العبودية والذي يصفه بيرت مؤلف الكتاب بأنه كان موقفا "إيمانيا" شبهه بموقف النبي إبراهيم عندما صدع بأمر الله في ذبح إبنه. هذا الموقف الأخلاقي رآه لينكولن ذاتي الإثبات في إطار القوانين الطبيعية البشرية لمفهوم المساواة، موقف متعارض مع مشروعية الاختيار الديموقراطي ولكن لينكولن فرض رؤيته بالقوة المسلحة فكانت الحرب الأهلية الأمريكية التي راح ضحيتها مئات ألوف الأمريكيين. وفي هذا الصدد يقول مؤلف الكتاب: " إن أكثر المخاطر وضوحا للسياسات المبنية على توجهات مثالية أو سياسات الضمير، كما يقال، هي الوجود الدائم لمخاطر العنف والحرب، حيث أنه بالنسبة للذين لا يستطيعون أو لا يريدون أن يروا الأمور كما نراها، ربما لن يكون أمامنا من سبيل إلا فرض الأمر بالقوة."
ربما لا نحتاج للتاريخ الأمريكي هنا، حيث أنه في تاريخنا الإسلامي العديد من تلك السياسات المثالية ونتائجها الدموية، ولعل في تاريخ العنف الدموي الذي مارسته طائفة المعتزلة من منطلق إيماني متشدد دليل على ذلك.
نجح لينكولن في الحرب الأهلية وفرض تحرير العبيد بالقوة ضد مشروعية أهل ولايات الجنوب في الإختيار بالانتخاب الديموقراطي. ولكنه لم يعلم في حينه أن قراره النفعي المأساوي، بتعبير جون بيرت،سيكتب له النجاح أو انه سياتي مع مطلع القرن الحادي والعشرين برئيس أمريكي أسود!.
كيف نسقط على الحالة المصرية هذه النقطة الخاصة بالموائمة وقرار لينكولن بالحرب والعصف بنتائج صناديق الإنتخاب في ولايات الجنوب؟ كان لولايات الشمال جيشها الخاص ولولايات الجنوب كذلك بالمثل. أي أن العامل الجيوسياسي هنا تمثل في توزيع "العصبية" بحسب تعبير ابن خلدون أو القوة الجمعية المسلحة بالتعبير الحديث، بين الشمال والجنوب، وهو أمر بعيد كل البعد عن مصر وجغرافيتها العبقرية! حيث لا يمكن بعد ثورة يناير استخدام الجيش المصري بواسطة فصيل سياسي ضد آخر.
من هنا يمكن فهم الدور المركزي والمتفرد الذي يقوم به جيش مصر الحديثة منذ أنشاه محمد على قبل قرنين من الزمان. رأينا بدايات دوره في "هوجة" أحمد عرابي، ورأينا قمة هذا الدور مع ثورة يوليو- عبد الناصر، قبل أن يصيبه التجريف مع عصر مبارك، ثم التشويه المتعمد بعد ثورة يناير 2011 من جانب تيار الإسلام السياسي حتى يتسنى له الانفراد بالسلطة. ولم يمنعه ذلك من الإحتفاء بالجيش شكلا بعد تمكنه من إزاحة قيادات الجيش حينذاك. ولكن، هل حقا تمكن تيار الإسلام السياسي من تحجيم وعزل دور الجيش المصري الثابت تاريخيا والواجب "خلدونيا" نسبة إلى ابن خلدون الذي قال بأن الدولة تقوم على الدين – دعوة نبي أو قول حكيم – وتلزمها العصبية (القوة الجمعية المسلحة) لكي تستكمل بنائها؟ هذا ما سنعود إليه بنهاية المقال.
طبيعة الصراع
يبدأ جون بيرت مؤلف الكتاب من مشكلة كيفية حل النزاع في مجتمع مفتوح. ويتسائل، هل تفترض الليبرالية مسبقا الاتفاق حول جوهر أخلاقي مشترك؟ في الحالة الأمريكية: كل الرجال متساوون طبقا للدستور، أم أن الأمر ليس إلا صراعا بين فئات متعددة من البشر بقيم ومصالح مختلفة، يتفقون فيما بينهم بالعمل معا لأسباب إنتهازية محضة؟ في الحالة المصرية في القرن 21 فإن الجوهر الأخلاقي المفترض الاتفاق حوله هو أصل الصراع نفسه! لأنه يتمحور حول التفسير الديني لمفاهيم الحياة عموما وليس الأخلاق فقط. وبما أن نفسير الدين أمر مختلف عليه بين الأديان عموما وبين طوائف الدين الواحد أيضا، فإن مبدأ الدولة الدينية ينسف منطق المقارنة مع حالة الديموقراطية الأمريكية التي بين يدينا، والتي هي بالأساس ليبرالية. إذن فإن الأجابة المصرية، بغض النظر عن الأمريكية، هي الصراع والإنتهازية المحضة.
هل يفسر ويؤكد هذه النتيجة ما نراه بوضوح ويتكشف كل يوم من صراع وانتهازية في مواقف قطبي تيار الإسلام السياسي الحاكم في مصر من إخوان مسلمين وسلفيين؟ المفارقة هنا، بغض النظر عن إنتهازية المعارضة الليبرالية، هو أن التيار صاحب المرجعية الأخلاقية الدينية هو الذي يمارس الصراع الإنتهازي بأوضح ما يكون، فأوقع نفسه في المتناقضة المطروحة هنا، حيث ألغى بنفسه مفهوم جوهر الأخلاق كأساس للديموقراطية، ونسف بذلك أي أمل في بناء مصر الديموقراطية في المستقبل المنظور.
دور الجيش ولينكولن العصر
إن ما نراه ونسمعه مؤخرا من تواتر تصريحات قادة الجيش على مستويات متعددة (قائد عام، ورئيس أركان، وحتى قائد جيش ميداني) هو إشارة واضحة لاستعادة جيش مصر دوره التاريخي الحتمي في تامين الدولة المصرية وضمان حيادها عن أي فصيل سياسي بعينه. وهنا يظهر الفرق الأساسي عند المقارنة بالحالة الأمريكية المنظورة في هذا المقال. لم يعد هناك مجال لاستخدام أي فريق سياسي للقوات المسلحة ضد خصومه السياسيين.
يمكننا، من منظور ما، إعتبار أن جمال عبد الناصر كان لينكولن مصر في منتصف القرن العشرين بفارق قرن كامل عن لينكولن الأمريكي. حيث أنه وفي إطار ظرفه التاريخي، تمكن بالفعل من فرض رؤيته الأخلاقية في العدالة الإجتماعية (مقابل إلغاء العبودية للينكولن) وذلك بالثورة وبالقوة المسلحة ضد شرعية ملك كان موجودا. إلا أن عبد الناصر، بعكس لينكولن، لم يقم الموائمة اللازمة بين الديموقراطية والقيم الأخلاقية أثناء حكمه، وقد دفعت مصر ثمن ذلك عندما ورث عبد الناصر خليفة خليفته، مبارك، الذي أطاح بالقوانين الأخلاقية الطبيعية وأحل محلها فسادا عم البر والبحر والجو!. وعندما لم تعد هناك ديموقراطية العصر ولا أخلاق عبد الناصر، كانت ثورة يناير 2011 تصحيحا من الشعب المصري لخلل الموائمة للإشكالية الفلسفية بين قانون الأخلاق الطبيعي ومشروعية نتائج الإنتخاب الديموقراطي. ولكن هل أتت ثورة شباب يناير بلينكولن أو ناصر القرن الحادي والعشرين؟ لا، لم تفعل، فكيف هو المستقبل المنظور لمصر" في غياب الموائمة الأخلاقية / الديموقراطية كما أوضحناها، هذا هو سؤال كل مصري الآن.
يختتم مؤلف الكتاب بقوله: "إن المبادئ بدون موائمة هي محض فراغ، وان الموائمة بدون مبادئ هي حقا عمياء". هذا هو الدرس القيم الذي يراه المؤلف صالحا للسياسيين حتى في يومنا هذا. فمن لمصر برجل رشيد وليس مرشد جماعة ليست مبرأة من الكذب والإنتهازية؟ من لمصر بلينكولن أمريكا القرن التاسع عشر ليوائم بين الأخلاق ومشروعية "الصندوق" إياه!، أو بناصر مصر القرن العشرين ولكن بموائمة جديدة في ثوب ديموقراطي يناسب العصر؟.
مسعد غنيم
20 فبراير 2013

