 | |  | | | الجــهـل قــــــوة 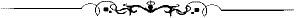
 | | الجــهـل قــــــوة | |
بقلم : مسعد غنيم
....................
سؤال غاضب من شاب ثوري جائني وناقشني بغضب واضح معترضا على مقالي السابق "الربيع العربي الإسلامي: رؤية خلدونية". هو شاب من شباب ثورة 25 يناير الذين إرتادوا ميدان التحرير تعبيرا عن رأيهم وتأكيدا لإرادتهم. يرى وائل، وهذا اسمه، أن مقالي يحصر الصراع على السلطة في مصر بين تيار الإسلام السياسي والمجلس الأعلى العسكري، ويتجاهل الأغلبية الحقيقة لشباب الثورة باعتبار أن أغلبية تيار الإسلام السياسي لا تعبر عن حقيقة أغلبية شباب الثورة. كما يرى وائل أن مقالي يبعث على التشاؤم ويكاد يقول بحتمية الهيمنة الأمريكية على الشأن المصري بناء على ما توصلت إليه من نتائج تحليل القوى العالمية والمحلية. ثم أنه يرى أن القوة المفاجئة للشعب المصري التي تفجرت في 25 يناير 2011 لا تخضع لحسابات القوى التي أتبعها عادة في مقالاتي عن الجغرافيا السياسية والتاريخ، ولذلك فهو لا يأبه كثيرا بثوابت أو بدلالات حركة التاريخ التي أعتمد عليها في التحليل، وكل ما يهتم به هو الروح الحضارية الثورية للشعب المصري، وهو ما يراه أمرا يصعب التنبؤ به كما حدث في ثورة يناير 2011.
وعندما سألت الشاب الغاضب: هل يمكن أن نتخلى عن ثوابت ومحركات التاريخ لصالح مشاعر وطنية حقيقية وقوة جماهير غير منظمة ولا مؤطرة في مؤسسات واضحة، وذلك في غيبة رؤية علمية بديلة؟! صمت الشاب قليلا وأجاب بالنفي، وبدا كأنه إقتنع بأنه من الأفضل أن نواجه الواقع بحقيقته المؤلمة أحيانا من أن نستغرق في حماس الشباب وقوة إيمانه بقضيته إلى حد فقدان الحس بالواقع، أو هكذا بدا لي!، ولكني وعدته بأن أظهر التفاؤل فيما أكتب لاحقا بشكل أكثر وضوحا. إلا أن مقال هذا الشهر، كان قد ترسخ في ذهني وهو بعنوان لا يبعث على التفاؤل، لذا سأحاول بقدر الإمكان، ألا أكتفي بالتحليل التاريخي ونتائجه المحبطة، وأن أتطرق إلى إستشراف طرق المستقبل وإستيضاح عوامل القوة الذاتية لشق هذه الطرق، والآن إلى مقال هذا الشهر.
الجهل في أمريكا
"أوضح النائب المحترم ما معناه أن الدولة تشجع الشباب على دخول الجامعات "الحكومية" وبذلك تضعهم في طاحونة تلقين تدمر الإيمان!. كما أن النائب المحترم يرى حقيقة أن زيادة عدد العلماء الأكاديميين الذين ينتسبون إلى التيار الليبرالي العلماني عن أولئك الذين ينتمون إلى حزب السيد النائب إنما هي مؤامرة "ليبرالية". قد يرى البعض أن العلماء يجدون صعوبة في دعم حزب يكون فيه إنكار "نظرية النشوء والإرتقاء" لداروين هو إختبار القبول لعضوية الحزب".
ليس هذا الكلام، عزيزي القارئ، عن نائب بالحزب المنتمي للإخوان المسلمين في مصر أو للسلفيين! ولكنه عن نائب في مجلس الشيوخ الأمريكي ينتمي إلى الحزب الجمهوري المحافظ! هذا كما ورد في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" للكاتب بول كروجمان بتاريخ 8 مارس 2012. النائب المحترم المشار إليه والذي يبدو سلفيا محافظا هو مستر "سانتورم" مرشح لرئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الجمهوري!!... كان عنوان المقال "الجهل قوة"! وذلك في تضاد ساخر مع المقولة الشهيرة "المعرفة قوة" للفيلسوف الإنجليزي فرنسيس بيكون في القرن السادس عشر/السابع عشر (1561 - 1626 ).
إن هذا المقال يطرح بعدين للقضية المطروحة، وهي العلم، البعد الأول إيبستيمولوجي (المعرفة)، والثاني أيديولوجي. والعلاقة بين البعدين هي علاقة عضوية في ثقافة أي شعب، والثقافة في جوهرها عملية سياسية كما يقول المفكر المغربي محمد عابد الجابري (1936 – 2010). وأن الهيمنة الثقافية كانت النقطة الأولى، وأحيانا الوحيدة المسجلة على جدول أعمال كل حركة سياسية أو دينية بل كل قوة إجتماعية تطمح إلى السيطرة السياسية، كما يقول الجابري.
لقد إخترت إقتباس عنوان هذا المقال عناونا لمقالي أيضا، لأن هناك مساحة تطابق بين الحالتين المصرية والأمريكية في هذا الشأن، رغم الفوارق الواضحة بين دولة أو إمبراطورية وبلد نامي، ولا أقول متخلف!. هذا التطابق يتمثل في العلاقة بين البعدين الأبيستمولوجي (المعرفي) والإيديولوجي، أو العلمي والديني بشكل مختزل لغرض هذا المقال. هذا مع تأكيد الفارق الصارخ في كل شئ آخر، فإن الأمر يطرح علامة إستفهام كبيرة تفرض نفسها علينا بأن نجد الإجابة عليها، إجابة تستوعب التاريخ، وتدرك كم التغير السريع والعالمي الذي نعيشه في كل مناحي حياتنا، كما تستشرف المستقبل بمنهجية علمية.
العلم والإيمان.... مرة أخرى
يأتي الجهل هنا بحسب تعبير كروجمان بمعنى أنه نقيض المنهج العلمي والمعرفة فيما يراه من المشهد الأمريكي بهذا الخصوص. والعلم ليس مجرد إكتناز المعرفة أو حيازة الشهادات العلمية حتى الدكتوراة، ولكنه منهجية التفكير، أي الفرض والتجربة والمشاهدة والإثبات المادي من خلال قوانين العلم وصرامة منهجه، وبعد ذلك كله فالعلم يقبل نقض الفكرة وإثبات خطئها، وبمعنى فلسفي فالعلم هو "كل ما يمكن إثبات خطئه". كما أن العلم لا يعرف اليقين، فقد أثبت هيزنبرج نظرية اللايقين في فيزياء الكم أو الكوانتيم بمطلع القرن العشرين. ولكن إذا كان اللايقين هو روح العلم التي تدفعه دائما للتطوير والإبتكار والإبداع، فإن اليقين المطلق هو روح الإيمان!، وهذا اليقين، نظريا، لا يجب أن يعيق الإجتهاد والإحياء والتجديد فيما يمكن التجديد فيه، ولكن هل هذا هو الواقع؟ .... في الواقع المعاش فإن كل ما يمكن أن نراه من تجديد لا يتعدى تجديد ماركة الهواتف المحمولة لكل فئات الشعب تقريبا، أو الحواسيب المحمولة أو السيارات للقادرين!.
العقل العربي ومنهجية العلم
رغم دعوات التجديد والإحياء لما يقرب منذ قرن تقريبا منذ أطلق الإمام محمد عبده مشروعه الإحيائي، فإن حال الأمة لا يوحي بأن هناك إجتهاد أو تجديد حقيقي. يؤكد هذا المعنى محمد عبد الجابري في مقدمة كتابه عن "تكوين العقل العربي". يقول الجابري: " ... ولكن واقع الحال، الآن، عكس ما كان يجب أن يكون، ... فقط من غياب محاولات رائدة وأخرى متابعة ومدققة....لقد تم خلال المائة سنة الماضية تكريس تصورات وآراء ونظريات حول الثقافة العربية بمختلف فروعها مما رسم قراءات معينة لتاريخ هذه الثقافة، قراءات استشراقية أو سلفية أو قومية أو يسراوية توجهها نماذج سابقة، أو شواغل أيديولوجية ظرفية جامحة، مما جعلها لا تهتم إلا بما تريد أن "تكتشفه" أو "تبرهن" عليه."
ثم ينتهي الجابري في كتابه ذلك إلى نتيجة واضحة بشأن موقع المنهج العلمي في العقل العربي حيث يقول: " لم تجد آراء ابن الهيثم ولا منهجيته العلمية "قابلة" في الثقافة العربية فلم يتردد لها صدى ولا كان لها أي أثر في تكوين العقل العربي، ولذلك فهي لا تجد نفسها، أعني أننا لانجد لها معنى وتاريخا إلا داخل الثقافة الأوروبية بالذات. ولكي ندرك مدى غربة آراء ابن الهيثم ومنهجه العلمي داخل الثقافة العربية تكفي المقارنة بين إنعدام أي صدى لما اصطنعه من شك علمي منهجي بناء، وبين الأصداء الواسعة المكتسحة التي كانت لـ"شك" الغزالي الميتافيزيقي الهدمي." إنتهى الإقتباس.
إذا كان الحال كذلك، فلدينا كل الحق في القلق على العقل المصري الآن بعد ثورة 25 يناير 2011، وهو مقبل على بناء مستقبل مصر بعد تجريف مواردها وعقولها لثلاثة عقود. سنحاول أن نفهم واقع منهجية العلم في المشهد المصري الحاضر وأن نستشرف مستقبل هذه المنهجية في ضوء ما يجري من تفاعلات بين القوى السياسية المختلفة، مدركين أن الثقافة هي نتاج الفعل السياسي. هذه المحاولة للفهم والإستشراف لا تتحيز ولا تتحزب مسبقا لفصيل سياسي دون الآخر على الساحة المصرية، وهذا هو أبسط شروط الموضوعية والمنهجية العلمية، وهو الشرط الذي إذا لم يتوفر في هذا المقال فسيفقد معناه وروحه.
بدءا بقراءة أحوال تيار الإسلام السياسي، نجده بعد أن سيطر على السلطة التشريعية، يحاول كتابة الدستور في إطار رؤيته الدينية، وهو في طريقه، على ما يبدو، للإستحواذ أيضا على السلطة التنفيذية ممثلة في منصب رئيس الجمهورية. وبإسقاط هذه الحقائق على موضوع مقالنا، فإن هناك خطر على وجود المنهج العلمي الذي ينتهج اللايقين، لأن التيار السياسي الذي يتصدر المشهد السياسي، تيار ينتمي في الأغلب الأعم إلى "الشك الميتافيزيقي" للإمام الغزالي وليس لـ"الشك العلمي المنهجي" لابن الهيثم!، بحسب تعبير الجابري.
في المقابل، فإن الحال لا يختلف كثيرا من حيث المنهجية العلمية، عند تفقد أحوال تيارات المعارضة السياسية الليبرالية/ العلمانية (مسلمون ومسيحيون). أعتقد أن التيار الثقافي العام، ليبرالي أو علماني، طبقا لرؤية الجابري، لا يبتعد كثيرا عن تصنيف تيار الإسلام السياسي في هذا المقام!!، فهو غالبا لم يأخذ من لفظة العلمانية منهجا للعلم بقدر ما أخذ منها إنتماء للعولمة ومظاهرها الثقافية العامة!. بمعنى أنه لا فرق "معرفي" هنا، وإنما يكمن الفرق فقط في التوجه العقائدي أو الإيديولوجي، فهذا سلفي، وذاك ليبرالي / علماني، ولعل عدد براءات الإختراع المسجلة باسم مصر تكون دليلا على عدم تأصل منهجية العلم حتى في المجتمع الأكاديمي!، والدليل على ذلك في الإحصاء التالي.
في عام 2011، بلغ عدد براءات الإختراع في ولاية بورتوريكو الأمريكية وهي من أصغر الولايات، بلغ إجماليه 28 براءة إختراع، بينما بلغ إجمالي العدد في الولايات المتحدة 121,247 براءة إختراع، وبلغ إجمالي العدد في إسرائيل 2,108 براءة إختراع، والكويت 24 براءة إختراع، بينما بلغ عددها في مصر 21 براءة إختراع فقط في 2011 وكانت 20 في عام 2010! أي أقل من كل من الكويت ووولاية بورتوريكو، وتمثل 1 % فقط من العدد في حالة إسرائيل!، و1.7 من عشرة من مائة ألف من الحالة الأمريكية! والجدول التالي يوضح تلك الأرقام بالتفصيل طبقا لموقع المكتب الأمريكي لتسجيل براءات الإختراع. تلك أرقام لاتقبل الجدل أو الإلتفاف حولها، ومقياس براءة الإختراع هو المقياس الأمثل لمدى التقدم العلمي للدول بعيدا عن الإدعاء الحكومي أو التزييف الإعلامي.
كلنا في الجهل عربُ
واقع الأمر أننا نسمع بين كل حين وآخر من نواب مجلس الشعب المصري من تيار الإسلام السياسي، وهم الأغلبية، من تصريحات يمكن تصنيفها داخل مربع "الجهل"، مما يضع الحزب الذي ينتمي إليه هذا النائب في موقف حرج تكرر كثيرا (حزب النور السلفي). وإن كانت تلك التصريحات تحسب على السذج والجهلة، فإن تصريحات بعض ممن يمكن وصفهم بالعلم والرشاد لا تختلف إلا في الدرجة من حيث التصادم مع العلم والعقل، حيث أنها كلها تستعلي بثقافة النقل على العقل، وتعادي، كما يفعل النائب الأمريكي السلفي، كل من الليبرالية والعلمانية، وتصنفهما في إطار الكفر والإلحاد!. حتى الآن على الأقل.
يأتي هذا التصادم مع العلم من أي من السلفيين هنا أو هناك متناقضا مع تأكيداتهم بأن عقيدتهم تحض على العلم وتحرص عليه! وكل يستشهد بآيات من كتابه المقدس!. يظهر هذا التناقض عندما يصطدم رأي بعض المؤمنين من خلال تفسيرهم للكتب المقدسة بطريقة حرفية. فإن آرائهم تصطدم ، مثلا، مع نظرية النشوء والإرتقاء (علم الأحياء أو البيولوجيا)، أو مع نظرية الإنفجار الكبير (علم الكون أو الكوزمولوجي). مثلا، فأهل الإنجيل أو الإنجيليون في جنوب الولايات المتحدة يصرون على التفسير الحرفي لآيات الإنجيل فيما يخص عمر الكون والكرة الأرضية، فيقولون بأن هذا العمر يبلغ 6 آلاف سنة فقط! بينما يثبت العلم بدرجة يقين كبيرة أن الديناصورات إنقرضت من على الأرض منذ حوالي 65 مليون سنة!، وأن عمر الكون يبلغ 13.72 مليار سنة (مليار وليس مليون!) بينما يبلغ عمر الأرض 4.5 مليار سنة فقط!!.
بهذا المنطق يمكن أن نرى أن الصدام مع العلم يمثل قاسما مشتركا بين السلفيين هنا وهناك، ولكن هذا لا يعني أنهما توحدا تماما، فليس هناك أي أمل في ذلك طبعا!. ومن ناحية أخرى نرى أن التيار الليبرالي / العلماني عندنا لم تتعدى ثقافته العلمية مستوى قشرة المنهج العلمي!. ولكن هناك فارق كبير بين هنا وهناك، هو أنه رغم تسلط ونفوذ الحزب الجمهوري وحزب الشاي (تي بارتي) كما يوصف، ورغم تعصبه العنصري وإغراقه في التطرف الديني من منطلق يهودي – مسيحي، ورغم أن 45% من الشعب الأمريكي ترفض نظرية التطور لداروين تمسكا بالتفسير الحرفي للإنجيل، فإن قيادة وإدارة الولايات المتحدة هي قيادة علمانية قحة تعتمد العلم طريقا أوحد للتقدم، ولا مانع لديها من توظيف الشعور الديني بذكاء لأغراض إنتخابية أو لتعبئة الرأي العام أثناء الحرب.
هناك تناظر محتمل بين كل من المشهدين الأمريكي والمصري فيما يخص إشكالية العلم والإيمان، وذلك في أن السلفيين الأمريكيين يخالفون جانبا جوهريا من نتائج العلم في مجال البيولوجيا صراحة وبوضوح شديد (45% من الشعب الأمريكي يؤمنون بحرفية تفسير الإنجيل في أن عمر الأرض 6 آلاف سنة فقط)، وأن المصريين المتدينين بطبعهم من المرجح أنهم ليسوا بنسبة أقل من تلك الأمريكية (ليس هناك أي إحصائيات مماثلة عن إعتقاد المصريين في حدود علمي). أيضا هناك إتفاق ظاهر بين كل من السلفيين هنا وهناك في الرفض الواضح والصريح لنظرية التطور لداروين باعتبارها مناقضة للمفهوم الديني المشترك للخلق طبقا للتفسير الحرفي للكتب المقدسة. هذا رغم أن هناك كثير من العلماء المتخصصين في الغرب والشرق لا يرون أي تناقض بين العلم والإيمان في هذا الشأن بشرط البعد عن التفسير الحرفي للنصوص المقدسة، أي بخطاب ديني جديد يناسب العصر ولا يتعارض مع العلم. أما عن مقارنة الليبرالية والعلمانية هنا وهناك فليس هناك صدام إيديولوجي، بينما الفارق "المعرفي" كبير جدا، ويكفي للتدليل على ذلك بنسبة براءات الإختراع في مصر مع نظيرتها في ولاية بورتوريكو وهي من أصغر ولايات الولايات المتحدة.
على كل، ليس موضوع الإيمان والعلم هو جوهر مقالنا هنا، كما أنه خارج مجال التخصص. ولكن ما استدعى هذا الموضوع هو المفارقة الكبرى بين إدارة إشكالية العلم والإيمان في كل من أمريكا ومصر رغم أوجه تشابه الفكر السلفي هنا وهناك من حيث التخاصم مع العلم، وأوجه الإختلاف المعرفي من حيث الدرجة بين الفكر الليبرالي/العلماني هنا وهناك. والناتج هو المفارقة في الإدارة العلمية الصارمة لشئون الإمبراطورية الأمريكية برغم التوجهات المحافظة المتشددة والمتعصبة دينيا (حالة بوش الإبن مثلا)!، هذا مقابل أنه يصعب على أي مراقب محايد أن يصف إدارة شئون الدولة المصرية طوال حقبة السادات العشرية وثلاثينية مبارك بأنها كانت إدارة علمية، هذا إن لم تكن بالعكس، أي وصفها بالغباء، أو حتى بالعمالة!.
تصب نتيجة هذه المحاولات للفهم في سؤال مركزي يخص هذا المقال، وهو ما مدى الإنسجام المتوقع بين منهجية العلم وإدارة مستقبل مصر؟ فلدينا تيار إسلام سياسي يتصدر المشهد السياسي ولاتنبئ مرجعيته الغالبة (الإمام الغزالي) ولا ممارساته (في مجلس الشعب) على أنه سينتهج المنهج العلمي لابن الهيثم! مثلا، ولدينا في المقابل معارضة ليبرالية / علمانية لم تأخذ، في الغالب المنظور، من العلم إلا صفة العلمانية، أي أن غياب المنهجية العلمية أمر ينطبق على كل من التيارين، أو بمعنى مباشر: "كلنا في الجهل عربُ"!! وذلك طبقا لتحليل الجابري للعقل العربي في المائة سنة الأخيرة.
التحدي الحضاري
هذا هو التحدي الحضاري أمامنا لبناء المستقبل: إلى أي مدى ستتبنى مصر منهج العلم وإستخدام العقل في إدارة شئونها؟! كما أن هناك إشكالية دائمة عند الحديث عن العلم والإيمان وهي إرتباط العلم الحديث بالغرب وتداخل تبني المنهج العلمي مع تبني المشروع السياسي للغرب وتوجهاته العدوانية الإستعمارية / التبشيرية أو الإلحادية، لا فرق، بكافة أشكالها القديمة والحديثة تجاه العالم العربي والإسلامي. هذا التداخل هو ما يدفع أغلبية عوام المصريين بطبيعتهم كـ "متدينين" إلى معاداة دعاوي العلمانية / الليبرالية ليس بإعتبارها مدخلا "معرفيا" للعلم الحديث ومنهجيته، بل باعتبارها مدخلا "دينيا" يدعو إما للإلحاد، أو للتبشير بالمسيحية. حتى مسيحيو مصر الأرثوذوكس (الأصوليون) يخشون على رعاياهم من تبشير الطوائف الإنجيلية في مصر!. وقد تؤخذ العلمانية باعتبارها مدخلا سياسيا عميلا لدعم المشروع الصهيو- غربي في المنطقة، كما يحدث في الهجوم على د. زويل، ليس من باب العلم ولكن من باب السياسة!. هذا التفاعل العضوي بين ما هو معرفي وما هو إيديولوجي سبق وأن طرحناه في هذا المقال.
لقد تم إستغلال هذا اللبس أو التفاعل بنجاح كبير من قبل تيار الإسلام السياسي في الإنتخابات البرلمانية ومن المرجح أن يتم إستخدامه في الإنتحابات الرئاسية القادمة. وبينما يمكن إحتواء نجاح تيار الإسلام السياسي في توظيف الدين لخدمة السياسية تحت دعاوي الديموقراطية حتى وإن كانت شكلية، لأنه في هذه الحالة تكون الخسائر قصيرة المدى أو تكتيكية. لكن يبقى الخطر الأكبر في أن يتم التلبيس بين العلم والأيدولوجية أو العقيدة الدينية، فيتم إقصاء منهجية "الشك" العلمي البناء لحساب يقين الإيمان أو "الشك" الميتافيزيقي الهدام بحسب رأي الجابري، لأنه في هذه الحالة ستكون الخسائر طويلة المدى أو استراتيجية. أعتقد أن هذا هو الخطر الحقيقي على مشروع نهضة مصر، والعرب عموما.
تلك كانت حقائق تاريخية عن موازين القوى، وعن الطبيعة المعقدة لتداخل الإيبستيمولوجيا مع الإيديولوجيا أو الشأن السياسي بالثقافي بالديني والعلمي، وكذا المؤشرات الإحصائية لقياس التقدم العلمي. قد تكون كلها صادمة للشاب وائل وأقرانه الثوريين، ولكنها واقع لابد لهم أن يبدأو منه إذا أرادو أن يؤسسوا مصر الحديثة على العلم والمعرفة حقا. فلا أعتقد أن البناء الحضاري يمكن تأسيسه فقط على أماني شباب الثورة أو مجرد حماسهم الوطني، ولا على مجرد إقتناء أحدث منتجات تكنولوجيا المعلومات من تليفونات وحواسيب محمولة وتابليت أو ألواح إلكترونية! كما أن الأمر بالتأكيد ليس رهنا بيقين ودعوات شيوخ و شباب تيار الإسلام السياسي وهي دعوات، إن صدقت، لا يعلم مدى الإستجابة لها إلا الله، خاصة وأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة! فيما نعلم بالواقع. على الأقل لم تعد تفعل ذلك الآن!.
لا يتمثل تفاؤلي في مجرد الأمل أو الأماني، ولكن في تصور وإستشراف طرق للمستقبل، إستشراف مبني على العلم والمعرفة بحركة المجتمعات، وبمحركات التاريخ، وبموازين القوى المحلية والعالمية في الصراع الجيوسياسي العالمي. هذا التصور يأتي في إتجاهين: الأول يصب في أن الشباب الليبرالي أو العلماني يمكنه أن يسعى لتحقيق هذا بعد أن يعرف حقا قيمة العلم ومعنى المنهج العلمي. وهنا يكون التحدي المفروض عليهم هو أن يتغلبوا على المعوقات الذاتية والتدخلات الخارجية. تتمثل المعوقات الذاتية في ضعف الثقافة العلمية والتصور الخاطئ للعلم في كونه الحصول على مزيد من الشهادات العليا بدلا من كونه منهجا في التفكير. أما التدخلات الخارجية فهي أوضح من أن تُعرَّف، وليس مشروع الهيمنة الصهيو-غربي عنها ببعيد. هذا المشروع لا يتصور أحد أنه يريد لمصر خيرا، وأول طريق الخير هو المنهجية العلمية.
الإتجاه الثاني لتصور إستشراف المستقبل يصب في إتجاه تيار الإسلام السياسي. وهنا لا أستطيع أن أكون متفائلا، فإني أشك كثيرا في إمكانية هذا التيار لتحقيق الحد الأدنى من التفكير العلمي المفتوح ليتغلب به على منهج النقل المقفول والإجتهاد القاصر حتى الآن على إحداث أي تجديد حقيقي للخطاب الإسلامي. ويأتي الشك على محورين: الأول بنيوي من حيث البنية الفكرية لهذا التيار وهي بنية أصولية سلفية لا تقترب كثيرا من المنهجية العلمية لابن الهيثم كما أوضحنا، والثاني ظرفي بحكم التفاعلات السياسية الجارية. فيبدو أن سكرة النجاح السياسي قد أصابت تيار الإسلام السياسي بغرور القوة، وعملت على زيادة قناعته بأن تمسكه بدينه، طبقا لقناعاته، هو سبب نجاحه على المستوى المحلي والإقليمي ممثلا في ترسيخ تواجد جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إقليمي إن لم يكن عالمي في نظرهم. أما عن تدخل الخارج فيتمثل في إستغلال مشروع الهيمنة الغربي لنجاح هذا التيار في عكس الإتجاه الذي يتصوره أنصار هذا التيار. وهذا الإتجاه العكسي يتمثل في دعم ترسيخ الإتجاه الديني (الإيديولوجي) على حساب المنهج العلمي (الإيبستيمولوجي)، ليس بغرض "نصرة الإسلام" بالطبع، ولكن بغرض دعم "الجهل" كما يراه كروجمان في مقاله المشار إليه!. والجهل هو أكبر قوة مدمرة عرفها الإنسان كما يقال.
إن ما أتمناه حقا هو أن يصبح الأصل في المعرفة العلمية لدينا هو قراءة كتاب الكون وقوانينه العلمية في الرياضيات النظرية والفيزياء، وفي طبيعة الجغرافيا وحركة المجتمعات ومحركات التاريخ وغيرها، وأن نعي أن الكتب السماوية هي كتب عقيدة وشريعة في المقام الأول، وليست كتب علم، وهو الأمر الذي يؤيده كثير من العلماء والفقهاء شرقا وغربا، قديما وحديثا.
بعد التساؤلات والإستشراف والأماني، لعلنا نكون قد أوضحنا إلى أي مدى ينطبق عل مصر عنوان مقال بول كروجمان "الجهل قوة" ؟!!! ويبقى أن نصر على بناء ثقافة علمية في مصر تضمن القيادة العلمية للدولة مثلما يفعل الأمريكان في الواقع العملي بعيدا عن إسقاطات السياسة وتجليات الإنتخابات الدينية؟.!! وبرغم أن "الجهل قوة"!!!
مسعد غنيم
إبريل 2012
06/11/2014
مصرنا ©
| | 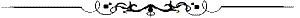
| | |
| |  | |  |
|
|

