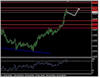بعد التقدم لأسفل، إلى أين تتقدم مصر؟
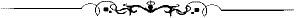
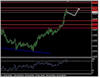 | |
المؤشر | |
بقلم : مسعد غنيم
....................
الدكتور جمال حمدان صاحب كتاب "شخصية مصر" له وصف متميز لمرحلة السادات وبدايات مرحلة مبارك في حكم مصر حيث وصفها بأنها مرحلة تقدم لأسفل وليس للخلف!، قبل أن يتوفى في ظروف غامضة عام 1993. ترى بماذا كان سيصف جمال حمدان طبيعة ذلك التقدم بعد تلك العقود الثلاثة التي أناخ مبارك طوالها بظله البليد على مصر؟ هذا قبل أن تقتلعه ثورة الشباب المصري في يناير 25 يناير 2011 وتقطع الطريق على توريث حكم مصر لإبنه من بعده. للإجابة على هذا السؤال يلزم أن نفهم المشهد المصري على مستويات متعددة: مشهد مباشر وآني لما يجري على سطح الأحداث، ومشهد أعمق وأكثر إمتدادا في الزمن لتفاعلات القوى المحلية، ثم مشهد أكثر عمقا وإمتدادا في التاريخ لتفاعلات القوى العالمية.
على مستوى المشهد المباشر، وفي ذكرى مرور عام على الثورة فأول ما يبصره المشاهد هو ذلك المشهد الذي وصفته جريدة الأهرام بأنه "يوم تعجز كل مفردات اللغة عن وصفه, خرجت الملايين من شعب مصر أمس إلي الميادين والشوارع لتكتب ميلادا جديدا للثورة". مشهد يجدد الثورة بقوة وإصرار ملايين المصريين في ميدان التحرير وميادين التحرير في المدن المصرية الأخرى للمطالبة بإنهاء "حكم العسكر" والقصاص لشهداء الثورة الذين تخطوا الألف شهيد، ومصابيها الذين يعدوا بالآلاف. هذا التجديد الهائل للثورة جاء داحضا ومكذبا لخطاب التخويف الذي إستخدمه المجلس الأعلى العسكري بكثافة ومنذ أحداث مجلس الوزراء، وقبل ما يقرب من أسبوع على موعد ذكرى الثورة، إستخدم الإخوان المسلمون في جريدتهم "الحرية والعدالة" نفس فزاعة التخويف من فوضى قادمة مع ذكرى ثورة 25 يناير.
إذن فالصورة هنا تقول بأن كلا من الطرفين، المجلس العسكري والإخوان المسلمون، إتفقا على محاولة منع التجمع الملاييني في ذكرى الثورة بإستخدام الترهيب والتخويف من تخريب محتمل في إطار حملة مستمرة لـ"شيطنة" شباب الثورة. وفي فعل عكسي وطبقا لمنهجهم البراجماتي النفعي، قام الإخوان المسلمون بالمشاركة بخبرتهم التنظيمية في تأمين الميدان، وهو تصرف محسوب بحرص يحسب لهم في الحالتين، ففي حالة حدوث الفوضى التي حذروا منها يكونوا قد قاموا بواجبهم في حماية الثوار، وإذا مر اليوم بسلام يكونوا قد شاركوا في إحياء الثورة مرة أخرى. هذا رغم أن وجودهم ووجود شعاراتهم داخل الميدان لم يصل إلى حد تحقيق الأغلبية التي تمكنوا من تحقيقها داخل مجلس الشعب المنتخب، فقد توحدت معظم الشعارات كما أراد شباب الثورة أصلا.
يتمثل الجزء المقابل من المشهد في إجتماع تم قبل يومين فقط من تجديد الثورة، وذلك لأول مجلس شعب منتخب بعد الثورة إنتخابا حرا بدرجة لم يحدث في مصر منذ زمن بعيد، وكان من أبرز نتائج هذا الإجتماع بعد وضوح فرحة تيار الإسلام السياسي بالفوز بالغالبية في المجلس هو تشكيل "لجنة تقصي" حقائق للتحقيق في مقتل الشهداء وإصابة المصابين، وهو الأمر الذي لم يرض الثوار في ميدان التحرير حيث أعتبروه تسويفا لا يليق بقدسية وحرمة دم الشهداء.
كان هذا هو السطح المنظور من المشهد المصري الآن، ولكن قراءة المستوى التالي من المشهد تتطلب قراءة ما تحت هذا السطح من تيارات تحدثها القوى المتصارعة على الساحة المصرية، ويمكن أن نستشف بعضا من طبيعة توجهات تلك القوى من واقع تصريحات وأقوال رموزها البارزة على الساحة.
كان قد صدر عن كثير من رموز تيار الإسلام السياسي قبل الإنتخابات وحتى بعد إنعقاد أول جلسة لمجلس الشعب تصريحات وإيحاءات توحي بمستقبل تفرض فيه أغلبية التيار السياسي الإسلامي مفاهيمها من منطلق فهمها لشريعة الله كما يرونها، وذلك على المجتمع المصري، وهذا يتفق ومشروعهم التاريخي المعروف منذ إنشاء جماعة الإخوان المسلمين على يد مؤسسها حسن البنا، وكما هو معروف عن توجهات الجماعات السلفية. هذه التصريحات المقلقة لم يخفف منها محاولات الإنتقاء التي تلتها بالتصريح بما يقبله المجتمع وإخفاء ما يمكن أن يرفضه خاصة بشأن قضايا العدالة الإجتماعية وحقوق المرأة وحقوق الإنسان في ظل تفسيرهم للشريعة الإسلامية.
لو صحت هذه القراءة فهي لا تبشر بمستقبل ديموقراطي كما تنتظره قطاعات الشعب المصري الذي صنع شبابه الثورة في المقام الأول، وتبقى هنا إشكالية بين نتائج الإنتخابات المتمثلة في أغلبية للتيار الإسلامي، وأغلبية أخرى مدَّعاة لشباب الثورة والليبراليين الذين يبررون عدم حصولهم على الأغلبية في البرلمان بنقص الخبرة السياسية مقارنة بخبرة الإخوان المسلمين من ناحية، وبإستخدام السلفيين لمنابر المساجد للدعاية الإنتخابية من ناحية أخرى، وهي إشكالية لا تغير شيئا من القبول بالأمر الواقع والمطابق حقيقة لقيمة وعمق التدين لدى الشعب المصري. إلا أن قراءة هذا الجزء من المشهد بشكل صحيح لابد وأن تضيف خلفية تلك الثورة عند إنطلاقها عندما إلتحق بها التيار الإسلامي بعد أن كانت بعض فصائله التي وصلت إلى مقاعد مجلس الشعب اليوم تحرِّم الخروج على الحاكم! قبل وأثناء أحداث الثورة. وبشكل عام فإن تلك التصريحات أشاعت كثيرا من القلق لدى قطاعات ليست قليلة من الشارع المصري، كما أعطت المبرر المنطقي للتيار الليبرالي ليهاجم تيار الإسلام السياسي ويصفه بالإنتهازية والنفاق، وبأنه سيقود مصر إلى مستقبل مظلم.
لا يقلل من قيمة هجوم التيار الليبرالي قيام التيار الإسلامي، خاصة السلفي، بإقصاء رموزه التي تورطت في التصريحات المستفزة لمشاعر وتوجهات كثير من المصريين، هذا ومع كامل إحترامي للأستاذ فهمي هويدي في دفاعة او تبريره لهذا التيار السياسي الإسلامي في هذه النقطة، فإني قد لا أتفق معه تماما في أن تلك التصريحات تعد إستثناء صدر من البعض ولا يمثل الكل، فأنا أعتقد أن ذلك البعض لم يأت بما قال من فراغ أو نتيجة حماس مؤقت، ولكن من قناعات تبدو راسخة وقديمة وعلى مستوى منهج وسياسات تلك الجماعات. ومن موقف مقابل من حيث الإنصاف، يلزم أن نقول بأن التيار الليبرالي لا يمكن هو الآخر أن يدعي "الطهارة" الديموقراطية، وقد كان بعض من رموزه يطوف في حلقات ذكر لجنة سياسات النجل الموعود بالوراثة والقابع الآن خلف قضبان سجن طره!، فشاركوه شطحاته الرأسمالية المتوحشة التي زادت فقر المصريين فقرا، وتغاضوا عن فساده الذي صعد بالمفسدين إلى عالم المليارات بينما يكافح المصريون للحصول فقط على لقمة العيش. كما أن بعض الليبراليين لم يراع في طبيعة تدين المصريين إلاَّ ولا ذِمة عندما تخطوا خطوطا حمراء كثيرة من باب حرية الرأي والتعبير.
كما أنه من المهم أن نتذكر أن تيار الإسلام السياسي هو بطبيعته رأسمالي من حيث البعد الإقتصادي، وأن كثيرا من مؤيديه هم من كبار الرأسماليين الذين لم يحد من طموحاتهم "الرأسمالية" إضطهاد نظام مبارك ونجله لهم، بل وعرفوا كيف يتعايشون معه في براجماتية أو نفعية واضحة!. بل إن الفقر والتهميش الناتج عن السعار الرأسمالي الفاسد لمبارك ونجليه وعصابته كان، من وجهة نظر ما، يصب في صالح تيار الإسلام السياسي! كيف ذلك؟..لا يمكن أن نتجاهل أن القوة الضاربة من الأصوات الإنتخابية التي صوتت لصالح الإسلام السياسي – بغض النظر عن مخالفته لقواعد عدم تأسيس أحساب دينية - تركزت في الأساس في الأحياء الفقيرة والعشوائيات سواء في المدن الكبرى أو الأصغر، وفي عمق القرى المصرية حيث يتوطن الفقر والجهل والمرض. ولعل في النجاح الواضح للتيار الليبرالي في أحياء الطبقة المتوسطة مثل مدينة نصر ومصر الجديدة مؤشر هام على ذلك التوزيع الإقتصادي لأصوات الناخبين، وهو الأمر الذي يفهمه المتخصصون في علم الإجتماع السياسي.
بالطبع لم يكن الفقر وحده كافيا لحصول تيار الإسلام السياسي على أصوات الفقراء، ولكنه كان التربة المثالية للإستثمار السياسي وكسب التعاطف الجماهيري من خلال العمل الخيري وخدمة الفقراء، وبالطبع لا يمكن ولا يحق لأي إنسان أن يحكم على نية فاعل الخير ولا يمكن التشكيك في خير يتم تقديمه خاصة مع الإضطهاد الذي مارسته الدولة البوليسية البغيضة لكل من يسعى للتقرب من الجماهير سواء في المسجد أو من خلال الجمعية الخيرية. وبالطبع فإنه من الإنصاف أيضا أن نذكر أننا لم نسمع يوما أن الإخوان المسلمين أو السلفيين قد منعوا أحدا من أن يمد يده بالعون إلى الفقراء والمهمشين في العشوائيات وأحياء الفقر والجهل، وأن خطأ الليبراليين في عدم الوصول إلى الجماهير يقع على عاتقهم وحدهم، حتى اليساريين المفترض فيهم الإنحياز إلى الطبقة العاملة والفقيرة بطبيعة التوجه الإيديولوجي، لم يحققوا نجاحا في التواصل مع الشعب، وهنا أمر جدير بالملاحظة من حيث أنه يتسق ويتطابق مع أوضاع اليسار العالمي في معظم دول العالم الآن حيث لا يحقق أي نجاح.
في الجانب الآخر والأهم من المشهد على مستوى تفاعلات القوى نجد أن شباب الثورة قد تفوق وجودهم في ميدان التحرير عشية تجديد الثورة في 25 يناير 2012 على وجود التيار الإسلامي، وذلك في تناقض واضح مع الأغلبية الظاهرة لتيار الإسلام السياسي في مجلس الشعب!. هذا التناقض يمكن رؤيته بوضوح في الصراع الذي برز الآن بين البرلمان والميدان كما يقولون. وفي الطرف الثالث من معادلة القوى الفاعلة نجد المجلس الأعلى العسكري يمارس دورا يتراوح بين تفاهم غير واضح مع تيار الإسلام السياسي، وسوء تفاهم واضح مع قوى شباب الثورة، مع عدم وضوح أهدافه الخاصة كمؤسسة وطنية عريقة. تلك الأهداف يفسرها البعض في إطار المشهد المصري العام بالتواطؤ مع التيار الإسلامي مقابل الخروج الآمن لأعضاء المجلس، بإعطائه جزء من السلطة والإحتفاظ بجزء آخر يحفظ للمجلس إمتيازاته وخصوصيته. وهذه المعادلة في إقتسام السلطة تتفق والتفسير الشائع للدور الأمريكي الذي يتم لعبه للحفاظ على توازنات القوى العالمية في الإقليم لصالح أمريكا والغرب، ولذا بادرت كل من أمريكا وإسرائيل بالتفاهم مع "الإسلاميين"، كما يسمون في الغرب، مع الإحتفاظ بالعلاقات الخاصة مع المجلس الأعلى العسكري، وهذا الجزء من المشهد ينتهي بنا إلى المستوى الأكثر عمقا من المشهد وهو تفاعلات القوى العالمية.
كانت تلك قراءة مباشرة لمستوى ما تحت سطح المشهد المنظور على الساحة المصرية. والآن، ما هو المشهد الأكثر عمقا لتفاعلات القوى الخارجية؟... من أفضل المؤشرات التي تساعد على إجابة مثل هذا السؤال هو القراءة الواعية للتاريخ، فإذا نظرنا لمسار تقدم مصر منذ مائتي عام عندما بدأ محمد على مشروع نهضة مصر الحديثة، نجد التاريخ يخبرنا أن ما بدأه محمد على قد إنتكس إلى إحتلال إنجليزي مباشر في سياق سباق عصر الإستعمار الأوروبي للشرق، إستعمار لم يكن ليتسع لطموح محمد على ولم يكن ليترك لمصر أي فرصة لنهضة حقيقية تعوق مطامع الإستعمار الغربي، ببساطة لأن مصر تقع في عنق الزجاجة في طريقه إلى الشرق المستهدف. كما سنقرأ في صفحات التاريخ أن دَفعة التقدم التالية جاءت مع ما بدأه عبد الناصر منذ ستين عاما للتخلص من الإحتلال الإنجليزي وتحقيق العدل الإجتماعي، وهو المشروع الذي إنتكس أيضا إلى إحتلال صهيو- أمريكي غير مباشر في سياق عصر الحرب الباردة بين الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي. ذلك الغرب الرأسمالي لم يكن هو الآخر، وبالأحرى، على إستعداد لترك أي فرصة لتنمية حقيقية لمصر، خاصة مع بدء خطوته التالية نحو السيطرة على الشرق بإنشاء دولة إسرائيل عام 1948كرأس حربة للغرب في الشرق تزامنا مع بدء إنحسار الإستعماري الأوروبي وبعد إنتصاره في الحرب العالمية الثانية، ثم تثبيت تلك الدولة "المصنوعة" لصالح الطموحات الجيوسياسية لأمريكا في حربها الباردة مع الدب السوفييتي، وذلك بتوجيه ضربة قاضية لمشروع النهضة العربي بقيادة مصر عبد الناصر عام 1967.
من المهم هنا أن نلاحظ أن دعم الغرب لإسرائيل لم يفرق بين حالتين لمصر؛ الأولى تحت نظام حكم ملكي مع ليبرالية سطحية في آواخر عهد أسرة محمد على في مرحلة إنشاء إسرائيل (1948)، والثانية تحت نظام جمهوري ثوري إشتراكي مع فترة حكم عبد الناصر في مرحلة التثبيت والدعم لإسرائيل (1967). هذا المنظور قد لا يتفق والتيار السائد لتفسير هزيمة 1967 بقصرها على التهويل من شأن العوامل الداخلية من أخطاء ثورة يوليو 1952، والتهوين من شأن نتائج مصالح وتدخلات القوى العظمى من منطلق جيوسياسية في المنطقة. هذا القصر الواضح في تفسير الهزيمة على أخطاء "عبد الناصر" يبرئ مشروع الهيمنة الصهيو-أمريكي من أي ذنب مباشر، ويصب في مصلحة إسرائيل مباشرة حيث يبرر العدوان المستمر لها على الشعب الفلسطيني والإستقطاع المستمر من أرض فلسطين حتى الآن، كما يزيد من إفقاد المصريين للثقة في أنفسهم وفي قواتهم المسلحة.
حتى مع التصحيح المؤقت للحالة المصرية بعد الهزيمة بإنتصار أكتوبر 1973، فإن الأمر سرعان ما إنحرف بسرعة مدهشة تحت حكم السادات للتوافق والإنصياع للمشروع الصهيو- أمريكي، ووصل إلى قاع الإنبطاح المهين مع حكم مبارك حتى أصبح مبارك نفسه هو "الكنز الإستراتيجي" لإسرائيل. هذه الملاحظة لطبيعة تأثير القوى الخارجية على المشهد المصري الآن تعتبر هامة لضمان القراءة الصحيحة للمشهد على جميع المستويات ومن جميع الزوايا، إستعدادا للإجابة على سؤال إلى أين تتجه مصر.
من المتفق عليه أن عصر مبارك الثلاثيني قد عمَّق من تقدم مصر لأسفل في أعماق الفقر والجهل والمرض، فعلى صعيد الجغرافيا تقزم دور مصر وتأثيرها الإقليمي، وعلى صفحات التاريخ سجل أسوأ فترات حكم مصر في العصر الحديث، بلادة وفسادا. والآن وبعد الإطاحة بالكنز الإستراتيجي لإسرائيل، بماذا سيأتي لمصر عصر التيار السياسي الإسلامي؟ ... للإجابة على هذا السؤال يجب أولا أن ندقق النظر في التوجهات المختلفة لهذا التيار، بعد نجاحه السياسي على الصعيد المحلي في الإنتخابات التشريعية على علِّاتها!.
في البعد الإقتصادي نجد أن التوجه هو رأسمالي بالأساس، حتى مع دعاوى "مشروع الإقتصاد الإسلامي". إن هذا التوجه الرأسمالي يستدعى بطبيعة الحال إلى الذهن ما نراه من أزمة رأسمالية عالمية في عقر دارها حيث إستلهمت جماعات "إحتلوا وول ستريت" ثورة الشباب المصري؟ ويستدعي أيضا ما نعلمه من أن مصلحة تلك الرأسمالية الغربية في الإستحواذ على موارد الشرق من مواقع إستراتيجية وبترول وغيره، لابد وأن تمر من خلال مصر كما كتبت صفحات التاريخ دوما، وكما عبر عنه جمال حمدان بـ "عبقرية الموقع والموضع".
وفي البعد السياسي لا يجب أن تخفى علينا دلالة إرتباط تلك المصالح الإقتصادية لذلك الغرب بالإعلان المبكر عن تفاهم تيار الإسلام السياسي بشقيه الإخواني والسلفي مع الغرب "العدو"!.
أخيرا ومن منظور تاريخي أبعد، يمكننا تلخيص تاريخ ثورات مصر الحديثة في ثورة القاهرة ضد نابليون والتي خرج من رحمها مشروع نهضة مصر على يد محمد علي، ثم ثورة يوليو ضد الإحتلال الإنجليزي والقصر الضعيف التي بدء بها عبد الناصر مشروع نهضة قومي، وتنتهي كل من تلك الصفحتين المضيئتين من تاريخ مصر بهجوم عنيف من الغرب الإستعماري بشكليه القديم والحديث إلى وأد المشروعين قبل أن يحققا نهضة حقيقية. فإذا كانت تلك القراءة صحيحة، وإذا كانت ثورة مصر في 25 يناير 2011 هي بطبيعة الثورات بداية لمشروع نهضة أخرى لمصر، أليس من المنطقي أن نستنتج أن ذلك الغرب "العدو" قد بدأ في بالفعل في الهجوم على تلك الثورة، وليس من المستبعد أن نتصور محاولاته لإجهاض الثورة وضمان عدم تحقيق أي نهضة حقيقية لمصر؟!
إن المسئول عن الإجابة على هذا السؤال الآن من الناحية العملية هو تيار الإسلام السياسي الذي تسلم السلطة السياسية بالفعل، ليس في مصر فقط ولكن في أكثر من بلد عربي في شمال إفريقيا. وأول ما يمكن أن يضعه في الإعتبار عند الإجابة هو أن تاريخ الغرب "العدو" لم يترك أي فرصة لنهضة شاملة في المنطقة، سواء من خلال مشروع حكم ملكي لأسرة محمد علي، أو من خلال مشروع قومي من خلال جمال عبد الناصر، فهل سيترك ذلك الغرب الآن تيار الإسلام السياسي ليحيي مشروع خلافة إسلامية قضى عليها الغرب بنفسه منذ قرن تقريبا وإستعمر على إثرها كل البلاد الإسلامية في المنطقة؟
أما لماذا إنهارت الخلافة الإسلامية ذاتها مع آخر "نسخة" منها، وهي الخلافة العثمانية، فهذا أمر آخر يحتاج إلى قراءة أخرى أكثر عمقا وشمولا لمعرفة المفاتيح الصحيحة للنهضة، وهي تتعلق في أهم جوانبها بحل إشكالية العلاقة بين العلم والإيمان، وهي الإشكالية التي نجح ذلك الغرب في حلها بشكل ما وتقدم وما زال يتقدم بالعلم وتطبيقاته التكنولوجية، بينما فشل مشروع النهضة العربي الإسلامي حتى الآن في حلها بعد سقوط الخلافة العثمانية، بينما إكتفى بإستخدام وإستهلاك منتجات ذلك العلم دون فك إشكاليته مع الإيمان. هذا هو السؤال التالي والأهم والذي يجب أن يجيب عليه تيار الإسلام السياسي بعد وصوله للحكم في مصر بعد "شوق" طال إلى ما يقرب القرن من الزمان، خاصة وهو متهم الآن من قبل الليبراليين "المنبهرين!" بالغرب بأنه، أي تيار الإسلام السياسي، يستهدف العودة بمصر إلى عصر الوهابيين، بما يعني إضافة التقدم إلى الخلف إلى التقدم إلى الأسفل كما وصفه جمال حمدان!. فهل يقرأ "الإسلاميون" المنتشون بفرحة النصر هذا النوع من الأسئلة أو يطرحونه على أنفسهم؟ ثم هل يستطيعون الإجابة عليها؟ أم أن مصر مقدر لها أن تفقد حقبة زمنية أخرى تتقدم فيها إلى الأسفل والخلف معاً قبل أن تحقق نهضة ملموسة مبنية على العلم والمعرفة في توازن مع روحها المتأصلة في الإيمان؟!
مسعد غنيم
26 يناير 2012