 | |  | | | نعم....الحب موجود 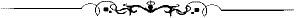
 | | الحب موجود | |
بقلم : مسعد غنيم
.....................
أستأذن القارئ الكريم في أن يتقبل مني الخروج قليلا عن نمط الكتابة الموضوعية في "مصرنا" لأخصص هذا المقال للحديث عن موضوع يرتبط بتجربة "شخصية". فقد أحسست بمدى صدق وعمق مشاعر الزملاء والقراء الأعزاء في "مصرنا" الذين سارعوا بمواساتي وعزائي في وفاة حبيبة عمري وزوجتي، ولا يسعني إلا أن أتقدم للجميع بخالص الإمتنان والدعاء للجميع بالصحة والسعادة وصبر من عند الله جميل عند المصائب. وموضوع هذا المقال هو الحب والموت!
من السهل الحديث عن أشياء في حياتنا حتى نخوض منها تجربة صعبة، وحينئذ فقط نبدأ في معرفة حقيقة ما كنا نتحدث عنه إدراك حقيقي لعمق المشاعر الإنسانية التي لا يسهل تقييمها بالمنطق والمعادلات الرياضية! والموت هو أفظع هذه الأشياء، وأفظع منه موت من تحب في وقت تعتقد أنه جاء مبكرا، رغم إيمانك بأن الأعمار بيد الله!
لا شك أن مسألة الموت هذه قد شغلت الإنسانية منذ أن وعت ذاتها، ولا شك أنه من أكبر المحركات إن لم يكن أعظمها على الإطلاق في إعمال الفكر الإنساني للإجابة عن السؤال الأبدي عن مغزى وجود الأنسان في حد ذاته، وبالتالي ماذا بعد الموت؟ وليس من قبيل المصادفة أن أعظم إنجازات الحضارة المصرية القديمة كان محركها الأول هو الرغبة في الخلود والتغلب على الموت بتحنيط الجسد وتخزين الإحتياجات معه إستعدادا للبعث.
ومن أشهر الأعمال الفكرية الحديثة عن "الموت" كتاب للمفكر الأمريكي إرنست بيكر بعنوان "إنكار الموت"، صدرعام 1973، وهو يجمع فيه بين الفلسفة وعلم النفس، وقد فاز بيكر بجائزة بوليتزر عن هذا الكتاب بعد وفاته بشهرين. يرى بيكر في هذا الكتاب أن الحضارة الإنسانية هي في النهاية آلية دفاعية رمزية ومقصودة ضد معرفتنا بأننا مخلوقات فانية، وهذه الآلية بدورها تقوم بدور الإستجابة العاطفية والعقلية لآلية بقائنا الأساسية.
ويقول بيكر بأن الثنائية الأساسية في الحياة الإنسانية توجد بين العالم المادي للأشياء والعالم الرمزي للإنسانية. وبالتالي فإن للإنسان طبيعة مزدوجة تتكون من ذات مادية وذات رمزية، وأن الإنسان قادر على أن يتسامي فوق مأزق الفناء من خلال "البطولة"، وهو مبدأ يتضمن نصفه الرمزي. ويتحدث بيكر عما يسميه "مشروع الخلود" وفيه يخلق الإنسان أو يصبح جزءا من شئ سوف يبقى للأبد، وبذلك يشعر الإنسان أنه قد "أصبح" بطوليا وبالتالي جزءا من شئ أبدي؛ شئ سوف لن يموت أبدا، مقارنة بجسده المادي الذي سيموت يوما ما. وهذا بدوره يعطي للإنسان الشعور بأن لحياته "معنى" و"غرضا" و "أهمية" في الإطار الأعظم للأشياء.
وكان لابد لبيكر أن يتعرض في كتابه لمنحى آخر هو كما يسميه "نظم البطولة" التقليدية للإنسانية ويعني بها الأديان، والتي يرى بيكر أنها لم تعد مقنعة في عصر العقل والعلم؛ كما يرى أن العلم يحاول أن يحل مشكلة الإنسان، إلا أنه يشعر أن العلم هو الآخر لن يستطيع ذلك أبدا!، أي أنه إنتهى إلى الجهل وعجز البشرية أن تجيب على السؤال. (مقتبس بتصرف عن موقع ويكيبيديا) وبالطبع فإن الغالبية العظمى من البشرية على طول تاريخها، من جميع الأجناس والعقائد، السماوية وغير السماوية، وبعيدا عن هذا الفكر العلماني لبيكر، تجد في الدين الملاذ الأخير للعزاء أمام الحقيقة الرهيبة للموت، إيمانا بالبعث بعد الموت وبلقاء الأحبة في الجنة...... ولكن حديثنا هنا ليس عن الموت!
نعم، ليس هذا حديثا عن الموت، بل هو حديث عن الحب، وما أقرب العلاقة بينهما لو دققنا النظر! إن ما تلقيته من عزاء من كل حلقات معارفي الإنسانية ومنهم زملاء وقراء أعزاء في "مصرنا" ليس عندي أدنى شك في حقيقة وصدق الحب الذي حرك مشاعرهم المساندة لي في محنتي، وشعرت لأول مرة كيف يبني ذلك الحب الإنساني حائط صد قوي ضد آثار ذلك الموت المجهول. لطالما شاركت من قبل، تماما كما تلقيت، كشأننا جميعا، "واجبات" العزاء كما ندعوها، ولا شك أنني شعرت بالحزن أثنائها كغيري بدرجات متفاونة تعتمد على درجة فداحة المصاب. فكان هناك دائما الموت العادي لأحبائنا الذين إستوفوا من حياتهم الكثير حتى أننا نتمنى لهم الموت رحمة بهم وبنا، وهناك من أحبائنا من يداهمهم الموت من حيث لا يحتسب أحد وتكون المصيبة فجائية وفادحة التكاليف من حيث مشاعر الحزن الدفين وعواطف الفراق المؤلمة، ولكم كانت هناك مصائب فادحة جدا. واليوم أشعر بالذنب لأنني لم أستشعر بالعمق الكافي مدى حزن أولئك الذين تعرضوا لهذه المصائب الصعبة من الموت. أشعر بالذنب لأنني بفقد محبوبتي وزوجتي إكتشفت بعدا أعمق للعلاقة بين الموت والحب، فلم أتخيل يوما أن يعتصر قلبي ووجداني ذلك الألم الرهيب من الحزن مثلما أشعر به الآن، وكأنما أسقط في ثقب أسود من الحزن لا يجدي العقل والمنطق معه شيئا وحيث تسقط جميع النظريات الفيزيائية الرياضية وتفشل في أن تقرأ أو تفسر أو حتى تعمل.
هو الحب إذن ما أعطى للموت ذلك الزخم وهذا الثقل. ولكن، هل لا يزال يوجد في عالم اليوم هذا النوع من الحب؟ ألم "يتعولم" الحب عبر الإنترنت والفضاء السيبرناطيقي ويصبح أقرب للمادية منه إلى الرومانسية؟ وهل ما زال هناك مجال لتلك الرومانسية بهذا العمق؟ تلك أسئلة أنساني الزمن وطول العشرة أن أطرحها على نفسي قبل رحيل محبوبتي وزوجتي لأننا كنا سويا نتنفس ذلك الحب كالهواء؛ مجرد أمر عادي لا نفكر بوجوده حتى. إلا أننا، والحق يقال، كنا بين الحين والآخر نذكر أنفسنا بأن لنا قصة مدهشة تجعل من حبنا في حكم النادر بين الناس. وما جعلها نادرة ليس إعتقادنا أو ظننا نحن الإثنان وذلك من قبيل النرجسية أو التقوقع حول الذات، ولكن ما جعلها كذلك هو رد فعل الحلقات المجتمعية حولنا مع إختلاف مواقعها وأزمانها لأكثر من أربعين عاما.
وقد فوجئت بمعظم ردود الفعل، إلا من الأصدقاء والأقارب المخلصين، بعد رحيل محبوبتي وزوجتي تركز على عدم تصديق عمق حزني عليها والإندهاش من عدم قدرتي على إستيعاب فراقها، بل والإستخفاف بجدية وجود مثل هذا الحب إلى حد الحكم بأن ليس شيئا طبيعيا، والتدرج في توصيف ذلك الحب بين إنكار وجوده أصلا أو تكذيبه، إلى توهم وجوده، إلى مثالية تعجز عن التكرار، أي أن ردود الفعل كانت في مجملها إنكارا واضحا بغض النظر عن نوع ذلك الإنكار. فلماذا ينكر الناس الحب الحقيقي عندما يرونه ويتأكدون منه؟!
إن هذا الإنكار للحب الذي وجدته في معظم دائرة المعارف والأقارب يتعارض مع إستقبال الناس بصفة عامة لقصص الحب في الروايات والأفلام، فمن منا لم يتأثر بكلاسيكيات الحب الرومانسي مثل "قيس وليلى" و "جميل وبثينة" و "تاج محل" و "روميو وجولييت"؟ ومن منا لم يذرف دمعا أو يكد عند مشاهدة الأفلام الأيقونية مثل أفلام عبد الحليم حافظ، والفيلمين الفرنسيين "رجل وإمرأة" و "الموت حبا" في ستينيات القرن العشرين، والفيلمين الأمريكيين "قصة حب" في سبعينياته، و "تيتانيك" في مطلع الألفية الثالثة؟
لماذا يتقبل معظم من أنكروا قصة حبنا بشكل أو آخر تلك الروايات والأفلام عن الحب الرومانسي؟ أعتقد أن الإجابة بسيطة، وربما أكون مخطئا، ولكن إعتقادي هو أن تصديق قصص أو أفلام الحب أو الإعجاب بها لا يتضمن مقارنة مباشرة بحال القارئ للقصة أو المشاهد للفيلم، فالأبطال هنا هم شخصيات عامة غير حقيقية أو قديمة ولا تمثل إتهاما مباشرا للقارئ أو المشاهد بأنه عجز من قبل أو هو عاجز حاليا عن أن يجد في حياته مثل ذلك الحب الرومانسي ويعيش في جنته كما رآها أو قرأ عنها. أما أن يكون صديقه أو جاره أو قريبه قد وجد الحب الرومانسي في حياته وعاش به عمره فهذا أمر يضع السامع أو القارئ أو المشاهد مباشرة في موضع المقارنة الحية، وبالتالي في موضع الإتهام بالفشل والنقص، وبالتالي يستلزم الأمر دفاعا سريعا، يأتي آليا ودون تفكير، وهو إنكار وجود ذلك الحب أصلا، فهو إما وهم أو كذب أو في حده الأقصى مثالية زائدة، غير واقعية وغير عملية في زماننا هذا!
من ناحية أخرى، فإني على يقين من أن هناك كثير جدا من قصص الحب وراء الأبواب المغلقة في بيوت هادئة بعيدة عن صخب الإعلام وإثارة الروايات والأفلام، إلا أن قصص الفشل والكراهية هي التي تنتقل بسرعة للأسف، فإذا كانت نسب الطلاق مرتفعة بين شباب اليوم، فإن باقي النسبة يقول بأن هناك الكثير أيضا ممن صمدوا أمام تحديات الفشل في الحب، ورعوا حبهم ولاذوا به من غوائل الزمن المتمثلة في الضياع وفقدان الهدف والمعنى. كما أن من وجدوا الحب في حياتهم أو بمعنى أصح صنعوا من حياتهم رحلة للحب، لا يشعرون بأي تهديد أو إتهام لهم بالنقص بسبب وجود نماذج لحب كبير قريبا منهم في حياتهم، بل إن ذلك ليكون حافزا لهم على التمسك أكثر بهذا الكنز الذي لا يفنى مصدرا للسعادة. ومن المؤكد أن وجود حالة حب حقيقية في محيط إجتماعي معين يمكن أن تكون مصدرا للإلهام لمن إنحرفوا عن هدف الحب وأثرت الأنانية بشكل سلبي على فطرتهم الطبيعية نحو الحب والإخلاص، حيث يمكنهم أن يصححوا من مسارهم ويجعلوا من بقية حياتهم نموذجا جميلا للحب بدون أنانية لأن الحب هو العطاء غير المشروط. ولهذا فبدلا من إنكار وجود حب حقيقي يرونه حولهم دفاعا عن نقص الحب في حياتهم، يستطيعون أن يستعيدوا الحب الذي بدأوا به حياتهم أزواجا، وأن يكملوا رحلة حياتهم وهم أكثر سعادة.
إذا كان هذا التفسير صحيحا، فلماذا أكتب إذن عن هذا الحب؟ والإجابة أبسط من سابقتها؛ إنني أكتب، وبكل تواضع، للذين إفتقدوا الحب في مرحلة ما من حياتهم ولديهم الإرادة لإستعادته، وللشباب المقبلين على الحياة يتلمسون طريقهم للعثور على الإجابة عن معنى لوجودهم. أكتب لأقول لهم أن الحب الرومانسي موجود، وموجود بأعمق وأعذب مما يتخيلون. وهذا الحب ليس بعيدا ليسافروا إليه، وليس مكلفا ليدفعوا ثمنه، وليس مستحيلا لييأسوا منه؛ هذا لأنه موجود بداخلهم هم أنفسهم، أزواجا وزوجات، فتيانا وفتيات. وليس عندي من دليل غير حياتي التي عشتها مع من أحببت ولم يفتر حبنا يوما، رغم صعوبات الحياة وفترات التوتر العادية بين كل البشر.
فالحب الذي عرفته لأكثر من أربعين عاما ما أتى إلا لأنني أنا ومحبوبتي وزوجتي آمنا به في داخلنا حتى قبل أن نتلاقى، أتي لأننا أعطينا من ذواتنا دون قيد أو شرط، أتي لأن كل منا ضحى من أجل الآخر دون حتى التفكير في فكرة المقابل، حتى أننا ولآخر لحظة في عمرها كنا نتباري في إستكثار بعضنا على أنفسنا، بمعنى أن كل منا يرى أنه ليس كفءا بما يكفي لإستحقاق نعمة الله عليه الممثلة في حبيبه، وكانت هي الأكثر حبا وتضحية، فقد تمنت أن ترحل قبلي لأنها لن تتحمل فراقي، وقد كان لها ما تمنت، وطوال حياتها وقبيل موتها لم تتفوه بشكوى واحدة خوفا على مشاعري من الألم، إلا أنها كانت تعلم أني أعلم، كما أعلم أنها تعلم أني أعلم، وهكذا كان حوارنا في أحيان كثيرة، الحب في صمت، وفي أيام الفراق كان لنا أكثر من مائتي خطاب حب تبادلناها على مدى سنوات عديدة شملت سنين تعارفنا وخطبتنا وزواجنا وحتى بعد إنجابنا لأبنائنا وبناتنا، ولا تستطيع أن تعرف أي منها أكثر حرارة وإشعاعا بالحب. وما لم نكتبه في خطاباتنا فقد سجلت الكثير منه في يومياتي على مدار سنين، ليشهد بعد رحيلها أن هذا الحب حقيقي كما هي الشمس في السماء، لا يفتر ضوؤها ولا يبرد دفؤها.
مسعد غنيم
20 أكتوبر 2011
45 يوما على فراق بثينة
06/11/2014
مصرنا ©
| | 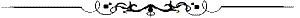
| | |
| |  | |  |
|
|

